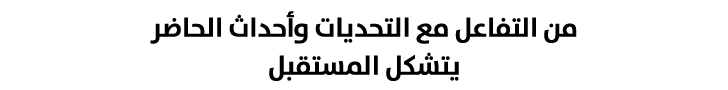الشرق الأوسط وحده القادر على إصلاح الشرق الأوسط

الشرق الأوسط وحده القادر على إصلاح الشرق الأوسط
الطريق إلى نظام إقليمي ما بعد أمريكا
شباط/فبراير 2023
بقلم: “داليا داسا كاي” و “سنام فاكيل”
أهم النقاط:
- الحرب في غزة لم تؤدِ إلى تحولات كبيرة في التوجهات السياسية الأساسية لواشنطن.
- الولايات المتحدة لم تغادر الشرق الأوسط عسكرياً بشكل فعلي، ولكن الشرق الأوسط بالتأكيد لم يعد في قلب اهتمامات الولايات المتحدة كما السابق، واندفاع إدارة بايدن للزج بقوى عسكرية بعد 7 أكتوبر موهم بأن هناك عودة أمريكية جدية للمنطقة.
- بعض القادة العرب، إلى جانب المؤيدين للتدخل في واشنطن، قد يكونون متحمسين لرؤية الولايات المتحدة “تعود” إلى الشرق الأوسط.
- سيل الزيارات المستمرة لكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية إلى المنطقة أظهر مدى ضآلة النفوذ الذي تحتفظ به الولايات المتحدة وصعوبة تأثيرها على الحليف الإسرائيلي.
- الديناميكيات الإقليمية والعالمية الحالية تجعل من الصعب جداً على واشنطن أن تلعب دوراً مهيمناً في فرض السلام في الشرق الأوسط. ولكن هذا لا يعني أن القوى العالمية الأخرى ستشغل محل الولايات المتحدة، فالقادة الأوروبيين أو الصينيين لم يظهروا اهتمامًا كبيرًا أو قدرة على تولي هذه المهمة.
- ستظل الولايات المتحدة لاعباً رئيسياً في المنطقة بسبب أصولها العسكرية وعلاقتها التي لا مثيل لها مع إسرائيل. ولكن أي توقع بأن واشنطن ستكون قادرة على تحقيق صفقة كبرى يمكن أن تنهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل نهائي هو أمر منفصل عن واقع الشرق الأوسط اليوم.
- ليس أمام دول المنطقة سوى المبادرة لتولي المسؤولية بشكل أكبر والتحرك بشكل جماعي لبلورة طريق ما للحل والمضي به معاً.
- الاستقرار الإقليمي سيكون في خطر مستمر طالما استمر الصراع
- لا يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منتدى دائم للأمن الإقليمي على غرار قطاعات أخرى مثل الطاقة والاقتصاد أو على غرار مناطق أخرى من العالم (مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورابطة دول جنوب شرق آسيا).
- توازن القوى التنافسي لطالما كان سمة مميزة لفن إدارة الدولة في الشرق الأوسط.
- الشرق الأوسط على مفترق طرق دقيق، إما أن يصاب بالشلل بسبب إراقة الدماء المروعة في غزة، وينزلق أكثر فأكثر إلى الأزمة والصراع، أو أن يبدأ في بناء مستقبل مختلف.
في الأسابيع الأولى من عام 2024، عندما بدأت الحرب الكارثية في قطاع غزة في إشعال المنطقة الأوسع، بدا أن استقرار الشرق الأوسط أصبح مرة أخرى في قلب أجندة السياسة الخارجية الأمريكية. ففي الأيام الأولى التي تلت هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، نقلت إدارة بايدن مجموعتين من حاملات الطائرات العسكرية، و غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط، بينما بدأ عدد كبير كبير المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس جو بايدن، بالقيام برحلات رفيعة المستوى إلى المنطقة.
بعد ذلك، ومع ازدياد صعوبة احتواء الصراع، ذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك، ففي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ورداً على الهجمات التي شنتها جماعات مدعومة من إيران على أفراد الجيش الأمريكي في العراق وسوريا، شنت الولايات المتحدة ضربات على مواقع أسلحة في سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني؛ وفي أوائل كانون الثاني/يناير 2024، قتلت القوات الأمريكية قائداً كبيراً لإحدى هذه الجماعات في بغداد. وفي منتصف يناير/كانون الثاني 2024، وبعد أسابيع من الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي، التي تدعمها إيران أيضاً، شنت الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة سلسلة من الضربات على معاقل الحوثيين في اليمن.
وعلى الرغم من هذا الاستعراض للقوة، فلن يكون من الحكمة المراهنة على التزام الولايات المتحدة بتأمين موارد دبلوماسية وأمنية كبيرة في الشرق الأوسط على المدى الطويل، فقبل وقت طويل من هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة قد أشارت إلى نيتها الابتعاد عن المنطقة لتكريس المزيد من الاهتمام بالصين الصاعدة. كما أن إدارة بايدن كانت تخوض الصراع المتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، مما يحدّ أكثر من قدرتها على التعامل مع الشرق الأوسط.
وبحلول عام 2023، كان المسؤولون الأمريكيون قد تخلوا إلى حد كبير عن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وسعوا بدلاً من ذلك إلى التوصل إلى ترتيبات غير رسمية لتخفيف التصعيد مع نظرائهم الإيرانيين. وفي الوقت نفسه، كانت الإدارة الأمريكية تعمل على تعزيز القدرات العسكرية للشركاء الإقليميين مثل المملكة العربية السعودية في محاولة لإزاحة بعض الأعباء الأمنية عن واشنطن، علماً أن بايدن تردد في البداية في التعامل مع الرياض -التي تعتقد الاستخبارات الأمريكية أن قيادتها مسؤولة عن مقتل الصحفي السعودي والمساهم في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي في عام 2018- ولكن لاحقاً أعطى بايدن الأولوية لصفقة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. وفي سعيها لإبرام الصفقة، كانت الولايات المتحدة على استعداد لتقديم حوافز كبيرة لكلا الجانبين مع تجاهل القضية الفلسطينية في الغالب.
لقد قلب 7 تشرين الأول/أكتوبر هذه المقاربة رأسًا على عقب، مؤكدًا على مركزية القضية الفلسطينية ومُجبرًا الولايات المتحدة على المزيد من الانخراط العسكري المباشر. مع ذلك فمن اللافت للنظر أن الحرب في غزة لم تؤدِ إلى تحولات كبيرة في التوجهات السياسية الأساسية لواشنطن. إذ تواصل الإدارة الأمريكية الضغط من أجل التطبيع مع السعودية على الرغم من معارضة إسرائيل لإقامة دولة مستقلة/منفصلة للفلسطينيين، وهو ما جعله السعوديون شرطًا لأي اتفاق من هذا القبيل.
لذا يبدو أنه من غير المرجح أن يتراجع المسؤولون الأمريكيون عن جهودهم الرامية إلى فصل الولايات المتحدة عن صراعات الشرق الأوسط. وعلى العكس من ذلك، فإن ديناميكيات الحرب التي تزداد تعقيدًا قد تؤدي إلى تراجع رغبة الولايات المتحدة في الانخراط في المنطقة. كما أن زيادة حجم الالتزامات في الشرق الأوسط لن تكون على الأرجح استراتيجية رابحة لأي من الحزبين السياسيين الأمريكيين في عام انتخابي حاسم.
كل هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تستمر في الانخراط في الشرق الأوسط، فإذا أسفرت الضربات الصاروخية على القوات الأمريكية عن سقوط قتلى أمريكيين أو إذا أدى هجوم إرهابي مرتبط بالصراع في غزة إلى مقتل مدنيين أمريكيين، فقد يفرض ذلك انخراطًا عسكريًا أمريكيًا أكبر مما قد ترغب فيه الإدارة الأمريكية. لكن انتظار أن تتولى الولايات المتحدة زمام المبادرة في إدارة غزة بفعالية، لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط سيكون أشبه بـ انتظار غودو -الذي لن يصل أبداً-، فالديناميكيات الإقليمية والعالمية الحالية تجعل من الصعب جداً على واشنطن أن تلعب هذا الدور المهيمن. ولكن هذا لا يعني أن القوى العالمية الأخرى ستشغل محل الولايات المتحدة.
فالقادة الأوروبيين أو الصينيين لم يظهروا اهتمامًا كبيرًا أو قدرة على تولي هذه المهمة، حتى مع تراجع النفوذ الأمريكي، وبالنظر إلى هذا الواقع الناشئ، فإن القوى الإقليمية – ولا سيما جيران إسرائيل العرب المباشرين مصر والأردن، إلى جانب قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة، التي تنسق فيما بينها منذ بدء الحرب – بحاجة ماسة إلى أن يخطو إلى الأمام وأن يحددوا معاً مساراً معيناً للمضي قدمًا.
القلق من النفوذ
على الرغم من الإحباط المتزايد من إدارة بايدن لعدم اتخاذها إجراءات حاسمة لإنهاء الحرب، إلا أن بعض القادة العرب، إلى جانب المؤيدين للتدخل في واشنطن، قد يكونون متحمسين لرؤية الولايات المتحدة “تعود” إلى الشرق الأوسط. وقد أوحى الرد الدبلوماسي والعسكري السريع لإدارة بايدن -واستعدادها لاستخدام القوة ضد الجماعات المتحالفة مع إيران- بأن المنطقة أصبحت مرة أخرى في قلب اهتمامات الأمن القومي الأمريكي، في الواقع، من حيث القوة العسكرية، لم تغادر الولايات المتحدة أبداً: ففي وقت وقوع هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان عشرات الآلاف من القوات الأمريكية متمركزين بالفعل في المنطقة، ولا تزال واشنطن تحتفظ بقواعد عسكرية كبيرة في البحرين وقطر، بالإضافة إلى انتشار عسكري أصغر في سوريا والعراق.
لكن النشاط العسكري والدبلوماسي للولايات المتحدة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر لم يبعث على الثقة. فمن ناحية أولى، كانت جهود الإدارة الأمريكية لمنع نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقاً متباينة بالتأكيد. ففي واحدة من أكثر النقاط الملتهبة المثيرة للقلق، وهي الصراع الإسرائيلي المحتدم مع حزب الله على الحدود اللبنانية، لم تتمكن واشنطن من منع العنف المتزايد من كلا الجانبين. فإلى جانب الخسائر العسكرية والمدنية الكبيرة، أُجبر عشرات الآلاف على إخلاء بلدات في شمال “إسرائيل” وجنوب لبنان. وقد رفض “حزب الله” حتى الآن سحب قواته من الحدود بمقابل حوافز اقتصادية، بينما تقول إسرائيل – التي اغتالت بالفعل مسؤولاً كبيراً في “حماس” في بيروت – إلى أن الوقت ينفد أمام الدبلوماسية.
وفي الوقت نفسه، كافحت الولايات المتحدة لاحتواء الضغط العسكري من وكلاء إيران في العراق وسوريا واليمن. فمنذ بداية الحرب، واجهت القوات الأمريكية في العراق وسوريا أكثر من 150 هجومًا من هذه الجماعات. وعلى الرغم من سلسلة من الضربات الانتقامية التي شنتها “الولايات المتحدة” و “المملكة المتحدة”، لم تتمكن واشنطن من وضع حد لهجمات الحوثيين التي لا هوادة فيها بالصواريخ والطائرات بدون طيار في البحر الأحمر. وقد تمكن الحوثيون بالفعل من إحداث اضطرابات كبيرة في التجارة الدولية، مما أجبر شركات الشحن الكبرى على تجنب قناة السويس. وجدير بالذكر أن محاولات الولايات المتحدة لحشد قوة بحرية متعددة الجنسيات لمواجهة هذا التهديد لم تتمكن من جذب الشركاء الإقليميين مثل مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، التي لا تزال حذرة من سياسات الإدارة الأمريكية في غزة.
ومع تضاؤل نفوذ واشنطن العسكري، ضعفت أيضًا “عضلاتها” الدبلوماسية. فبدلاً من إظهار العزم، أظهر سيل الزيارات المستمرة لكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية إلى المنطقة مدى ضآلة النفوذ الذي تحتفظ به الولايات المتحدة – أو في حالة إسرائيل، عدم رغبة الإدارة الأمريكية في استخدامه-، فخلال الأشهر الأولى من الحرب، كان أحد الإنجازات القليلة الواضحة للإدارة الأمريكية هو وقف القتال لمدة أسبوع واحد في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ما سمح بإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلي وأجنبي وإيصال مساعدات إنسانية متواضعة إلى غزة، ولكن حتى في هذه الحالة، كانت الوساطة القطرية والمصرية حاسمة. وبخلاف ذلك، لم تكن الولايات المتحدة راغبة (على الأقل حتى كتابة هذه السطور) في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، واقتصرت الدبلوماسية العلنية للإدارة الأمريكية في الغالب على الجهود الخطابية لكبح جماح أسوأ اندفاعات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية.
بدلاً من ذلك، كانت الإدارة الأمريكية أكثر وضوحاً في الترويج لأفكار السلام “اليوم التالي” التي تركز على ما تسميه قيادة “متجددة” للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والدعم الإقليمي لإعادة إعمار غزة. لكن القوى الإقليمية، ولا سيما دول الخليج العربية الغنية، أوضحت أنها لن تؤيد مثل هذه الخطط دون اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو إقامة دولة فلسطينية. وبعد أن بدأ المسؤولون الأمريكيون يتحدثون علنًا بشكل أكبر عن الحاجة إلى حل الدولتين كجزء من اتفاق تطبيع أكبر مع السعودية، رفض نتنياهو رفضًا قاطعًا هذا الاحتمال وأصر على ضرورة بقاء إسرائيل مسيطرة أمنيًا بشكل كامل على المناطق الفلسطينية. ولكن حتى المسؤولون الإسرائيليون “المعتدلون”، أعربوا عن دهشتهم من أن الولايات المتحدة تضغط على مبادرات السلام بينما تستمر الحرب الشاملة ضد حماس. وفي الوقت نفسه، أدى دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل في القتال وعدم تعاطفها الملموس مع معاناة الفلسطينيين إلى خلق عقبات كبيرة أمام جذب الدعم الإقليمي، ناهيك عن تأييد الفلسطينيين، لأي خطة تقودها الولايات المتحدة.
ستظل الولايات المتحدة لاعباً رئيسياً في المنطقة بسبب أصولها العسكرية وعلاقتها التي لا مثيل لها مع إسرائيل. ولكن أي توقع بأن واشنطن ستكون قادرة على تحقيق صفقة كبرى يمكن أن تنهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل نهائي هو أمر منفصل عن واقع الشرق الأوسط اليوم. ففي نهاية المطاف، من المرجح أن تأتي الاختراقات الدبلوماسية الكبرى من المنطقة نفسها وتعتمد عليها.
الذهاب بمفردنا، معًا
لم تقتصر عواقب تراجع نفوذ واشنطن في الشرق الأوسط على الصراع الحالي. فمع تراجع انخراط الولايات المتحدة في المنطقة في السنوات التي سبقت السابع من أكتوبر، زادت القوى الإقليمية الكبرى بشكل مطرد من جهودها في تشكيل الترتيبات الأمنية ووضعها. وبالفعل، ابتداءً من عام 2019، بدأت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة في إصلاح العلاقات التي كانت مشحونة في السابق. ولم تكن إعادة الضبط الإقليمية غير المعتادة هذه مدفوعة بالأولويات الاقتصادية فحسب – التغلب على الاحتكاكات التي عطلت أو أعاقت التجارة والنمو في السابق – بل أيضًا بسبب التصور بأن اهتمام واشنطن بإدارة صراعات الشرق الأوسط كان يتضاءل.
خذ على سبيل المثال التقارب بين دول الخليج وإيران. في عام 2019، بدأت الإمارات العربية المتحدة في استعادة العلاقات الثنائية مع إيران بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات، حيث رأت في ذلك فرصة لإدارة العلاقات بشكل مباشر وحماية مصالحها من الجماعات المدعومة من إيران التي كانت تعطل حركة الملاحة في الخليج وتهدد السياحة والتجارة الإماراتية. ثم استأنفت أبوظبي رسمياً العلاقات الدبلوماسية مع طهران في عام 2022، ممهدة الطريق أمام الرياض لتحذو حذوها. في مارس 2023، عندما أعلنت السعودية وإيران المتنافستان منذ فترة طويلة عن استئناف العلاقات بينهما في اتفاق توسطت فيه الصين بعد أشهر من المحادثات السرية التي جرت بوساطة عُمان والعراق. ولم يكن للولايات المتحدة أي دور في هذه الاتفاقات.
في هذه الأثناء، في عام 2021، أنهت البحرين ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة حصاراً استمر ثلاث سنوات ونصف السنة على قطر كان الدافع الرئيسي وراءه دعم قطر لجماعات الإخوان المسلمين، وعلاقاتها الوثيقة مع إيران وتركيا، وقناة الجزيرة التلفزيونية الناشطة، وفي الوقت نفسه تقريبًا، تصالحت الإمارات والسعودية مع تركيا، التي كانتا قد نبذتاها سابقًا ردًا على الدعم التركي لقطر والجماعات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين. (كانت العلاقات السعودية التركية متوترة أيضًا بسبب التحقيق القضائي التركي في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول).
ومن خلال استئناف العلاقات، فتح السعوديون والإماراتيون الباب أمام استثمارات خليجية مهمة في الاقتصاد التركي المتعثر. ثم في مايو/أيار 2023، دعا القادة العرب بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية مجدداً، مما يمثل نهاية أكثر من عقد من العزلة خلال الحرب الأهلية الوحشية في سوريا.
وكجزء من “إعادة الضبط” الأوسع نطاقًا، بدأت الحكومات في الشرق الأوسط أيضًا في المشاركة في مجموعة متنوعة من المنتديات الإقليمية. فقد جمع مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، -الذي انعقد للمرة الأولى في بغداد عام 2021 ومرة أخرى في عمّان عام 2022 لمناقشة استقرار العراق-، مجموعة واسعة من الخصوم السابقين – بما في ذلك إيران وتركيا، وأعضاء مجلس التعاون الخليجي، والأردن ومصر، وجمع منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تأسس في عام 2020، قبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن، إلى جانب ممثلين عن السلطة الفلسطينية، فيما صُمم ليكون حوارًا منتظمًا مبنيًا على أمن الغاز وإزالة الكربون. كما تم إنشاء ما يسمى بمجموعة I2U2، وهي مجموعة تضم الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في عام 2021 لتعزيز الشراكات عبر الإقليمية التي تركز على الصحة والبنية التحتية والطاقة.
ومن الجوانب الأخرى لعملية إعادة الضبط الإقليمية هذه تطبيع إسرائيل مع العديد من الحكومات العربية. في “اتفاقات أبراهام” لعام 2020، وافقت البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، مما خلق فرصًا لعلاقات اقتصادية وتجارية جديدة. والجدير بالذكر أن أحد أهداف الاتفاقات كان تمهيد الطريق لعلاقات أمنية مباشرة جديدة بين إسرائيل والعالم العربي. وقبل هجمات 7 أكتوبر، كان لدى إدارة بايدن آمال كبيرة في أن تنضم المملكة العربية السعودية، بصفتها عضوًا رائدًا في العالم العربي، إلى هذه المجموعة أيضًا. وبناءً على تلك الاتفاقيات، جمعت “قمة النقب” في مارس/آذار 2022 البحرين ومصر وإسرائيل والمغرب والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة لتشجيع التعاون الاقتصادي والأمني فيما كان من المفترض أن يكون اجتماعًا دوريًا.
ومع ذلك، كانت القضية الفلسطينية غائبة بشكل صارخ عن اتفاقات التطبيع، حيث تم تنحية القضية الفلسطينية جانبًا إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، رفض الأردن المشاركة في قمة النقب، ومع اشتعال التوترات حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في أوائل عام 2023، تم تأجيل اجتماع آخر للمجموعة مرارًا وتكرارًا. والآن، ومع الدمار الذي لحق بغزة، فإن أي تقدم إضافي في ضبط أوضاع المنطقة سيكون مرهونًا ليس فقط بإنهاء الحرب بل أيضًا ببناء خطة قابلة للتطبيق لإقامة دولة فلسطينية.
الاصطفافات الناشئة بين التمزق والمرونة
من الناحية النظرية، يبدو أن الحرب الكارثية في غزة تشكل تهديداً خطيراً لإعادة ضبط الشرق الأوسط. ففي معظم الأحيان، لا تزال العلاقات الإقليمية التي تأسست حديثًا هشة ولم تعالج بعد القضايا الشائكة مثل انتشار الأسلحة، واستمرار دعم الإمارات العربية المتحدة للجماعات المسلحة في ليبيا والسودان، ودعم إيران للميليشيات المسلحة غير الحكومية في جميع أنحاء المنطقة، وتصدير سوريا لمخدر الكبتاغون. وإلى جانب تعريض تطبيع العلاقات الإسرائيلية الناشئ مع الحكومات العربية للخطر، فإن التدخل المكثف للجماعات المدعومة من إيران – من حزب الله والحوثيين إلى الميليشيات المختلفة في سوريا والعراق – قد يؤدي إلى خلق تصدعات جديدة بين إيران ودول الخليج. ومع ذلك، فقد أثبتت عمليات إعادة الاصطفاف الناشئة حتى الآن أنها متينة بشكل مدهش.
فبدلاً من عرقلة العلاقات بين إيران والسعودية، يبدو أن حرب غزة قد عززتها. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حضر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اجتماعًا مشتركًا نادرًا لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي استضافه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، وفي الشهر التالي، التقى القادة الإيرانيون والسعوديون مرة أخرى في بكين لمناقشة حرب غزة. كما خطط البلدان لتبادل زيارات رسمية متبادلة بين رئيسي ومحمد بن سلمان في الأشهر المقبلة – وهي اجتماعات من المفترض أن تضفي الطابع الرسمي على العلاقات الاقتصادية والأمنية الجديدة. وعلى الرغم من التوترات المتصاعدة بشأن الحوثيين على وجه الخصوص، التقى وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير 2024، أيضًا.
وفي الوقت نفسه، لا تزال العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وشركائها في اتفاق أبراهام قائمة حتى الآن. وقد أوضحت الإمارات العربية المتحدة أنها تعتبر الحوار مع الحكومة الإسرائيلية، حتى في الأزمة الحالية، وسيلة مهمة لإحراز تقدم في التسوية السياسية الإسرائيلية الفلسطينية. وعلى الرغم من إدانة البرلمان البحريني للعدوان المستمر على غزة، إلا أن البحرين لم تقطع علاقاتها رسميًا مع إسرائيل. وبالنسبة لكلتا الدولتين العربيتين، لا يقتصر التطبيع على تعزيز الروابط الاقتصادية مع إسرائيل فحسب، بل أيضًا تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. فعلى الرغم من ابتعاد واشنطن الملحوظ عن المنطقة في السنوات الأخيرة، فلا تزال دول الخليج العربية تسعى للحصول على ضمانات وحماية أمنية أمريكية: ففي كانون الثاني/يناير 2022، صنف بايدن قطر “حليفًا رئيسيًا من خارج حلف الناتو”، وفي أيلول/سبتمبر 2023، وقعت البحرين والولايات المتحدة اتفاقية لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية.
ومن المؤكد أن الحرب قد خلقت عقبات جديدة أمام التعاون الإقليمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والدول المجاورة. فقد سحبت كل من تركيا والأردن سفيريهما من إسرائيل، وتوقفت الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب في أكتوبر/تشرين الأول. وبحلول أواخر كانون الثاني/يناير، ومع مقتل أكثر من 26,000 شخص في غزة وعدم وجود وقف لإطلاق النار في الأفق، أصبح الرأي العام العربي أكثر معارضة للتطبيع من أي وقت مضى. كما يخشى الكثيرون من أن تؤدي الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية على الحوثيين إلى تشجيع الجماعة في اليمن وانتكاسة الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع الرسمي على وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في حرب الحوثيين مع السعودية التي استمرت قرابة عقد من الزمن في اليمن. وعلى الرغم من التزام دول الخليج العربية بمواصلة التواصل دبلوماسيًا مع طهران، إلا أن القليل من المسؤولين في المنطقة يأملون في أن تغير إيران نهجها القائم على “الدفاع الأمامي”، والذي تعتمد فيه على الجماعات المسلحة لبناء نفوذ استراتيجي والحفاظ على قوة الردع. وفي منتصف كانون الثاني/يناير، أدّت الضربات الصاروخية المباشرة التي وجهتها طهران إلى العراق وباكستان وسوريا رداً على الضربات الإسرائيلية والهجوم الذي شنه تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة كرمان الإيرانية إلى زيادة التوتر أكثر فأكثر.
حالياً، هناك مؤشرات على أن قادة الشرق الأوسط يسعون إلى تجاوز هذه الخلافات. فعلى سبيل المثال، ولإدارة الضغوط الاقتصادية المتزايدة والاضطرابات في الداخل، أعطت إيران أولوية جديدة للعلاقات التجارية والتجارية الإقليمية ليس فقط مع دول الخليج العربية بل أيضًا مع العراق وتركيا ودول آسيا الوسطى، بالإضافة إلى الصين وروسيا. وهذا يشير إلى الدوافع البراغماتية التي تحرك توجهات طهران التي تسعى إلى تجنب الانخراط المباشر في الصراع في غزة على الرغم من دعمها لمختلف الجماعات الوكيلة. ولكن مع تصاعد الهجمات المتبادلة في جميع أنحاء المنطقة وغياب وقف إطلاق النار في غزة، قد تتغير حسابات إيران.
تأثير غزة
من المفارقات أن إحدى أقوى القوى التي تحافظ على تماسك المنطقة قد تكون محنة غزة نفسها والقضية الفلسطينية التي لفتت الحرب انتباه العالم إليها بشكل صارخ.
ففي مواجهة الغضب الشعبي العارم واحتمالات التطرف وعودة الجماعات المتطرفة على المدى الطويل، قام قادة المنطقة بمواءمة استجاباتهم السياسية للحرب إلى حد كبير. وعلى الرغم من تباين الاستراتيجيات تجاه إسرائيل والفلسطينيين قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، إلا أن الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط متحدة على نطاق واسع في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، ومعارضة أي عملية نقل للفلسطينيين إلى خارج غزة، والدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتقديم المساعدات بشكل عاجل، ودعم المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان بالإمكان توجيه هذه الوحدة نحو بناء عملية سلام شرعية ؟.
فبالنسبة للعديد من الدول العربية والإسلامية في المنطقة، كانت الأولوية القصوى هي تحديد خطة واضحة لغزة، وفي نهاية المطاف، إقامة دولة فلسطينية. وقد اقترح القادة الإسرائيليون أن تشارك دول الخليج ذات الموارد الكبيرة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في تحمل تكلفة إعادة إعمار غزة. لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية قالت إنها تعارض قيام دولة فلسطينية، ومع استمرار الحرب، لا توجد حكومات عربية مستعدة لتقديم مثل هذا الالتزام أو أن يُنظر إليها على أنها تتكفل بالمجهود الحربي الإسرائيلي. وبدلاً من ذلك، كشفت هذه الحكومات عن مقترحاتها الخاصة للسلام بعد الحرب.
في ديسمبر 2023، طرحت مصر وقطر خطة بدأت بوقف إطلاق النار مشروطاً بإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى على مراحل. وبعد فترة انتقالية، ستؤدي خطوات بناء الثقة هذه، من الناحية النظرية، إلى إنشاء حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
وستتألف القيادة الجديدة من أعضاء من كل من حركة فتح -الحزب الوطني الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة-، وحركة حماس، وستدير القيادة الجديدة الضفة الغربية وغزة بشكل مشترك، في ضوء مطلب إقليمي حاسم بعدم الفصل بين الأراضي الفلسطينية المختلفة سياسياً. وستتطلب هذه المرحلة الأخيرة إجراء انتخابات فلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية. وعلى الرغم من أن إسرائيل رفضت الخطة في حد ذاتها، سواء بسبب إدراج حماس أو بشأن مسألة إقامة الدولة، إلا أنها وفرت نقطة انطلاق لمزيد من النقاش.
وفي المقابل، طرحت تركيا بدورها مفهوم “نظام ضامن متعدد الدول”، حيث تقوم دول المنطقة بحماية وتعزيز الأمن والحكم الفلسطينيين، بينما تقدم الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضمانات أمنية لإسرائيل.
واقترح آخرون أن تدير الأمم المتحدة سلطة انتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو نهج من شأنه أن يتيح الوقت لإصلاح هيكل الحكم الفلسطيني ويمهد في نهاية المطاف لإجراء انتخابات فلسطينية.
ومن جانبها، صرحت إيران مرارًا وتكرارًا أنها ستعزز أي نتيجة يدعمها الفلسطينيون أنفسهم، مما يشير إلى أن هناك فرصة متجددة لإقناع طهران بدعم الاتفاق وتجنب دورها المفسد المعتاد.
وفي الوقت نفسه، تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير خطة سلام مع دول عربية أخرى من شأنها أن تشترط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بإيجاد مسار لا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية. وترتكز مقاربة الرياض على مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي التزمت بالاعتراف العربي بإسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية. وتتماشى الخطة السعودية الحالية مع مساعي واشنطن للتطبيع الإسرائيلي السعودي. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان السعوديون سيتفقون مع نظرائهم الأمريكيين على ما يشكل خطوات موثوقة ولا رجعة فيها نحو إقامة دولة فلسطينية، لا سيما في ظل المقاومة الإسرائيلية القوية.
ولا تزال الحكومة الإسرائيلية في عهد نتنياهو ترفض كل هذه المقترحات. ولكن حتى أواخر كانون الثاني/يناير، كانت إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق هدفها الحربي المتمثل في القضاء على حماس، ولم تتمكن بعد من تأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة متبقية. كما كانت هناك أيضاً توترات متزايدة في كل من مجلس الوزراء الحربي والجمهور الإسرائيلي حول المسار المستقبلي للحملة العسكرية. وعلاوة على ذلك، أرجأت البلاد أي نقاش عام أو سياسي جدي حول مستقبلها الأمني إلى حين انتهاء الحرب. وعندما يحدث ذلك، ستحتاج إسرائيل إلى فتح قنوات دبلوماسية مفتوحة مع الحكومات العربية وتأمين التمويل والضمانات الأمنية منها، فضلاً عن الحفاظ على مشاركة واشنطن خلال هذه العملية.
قد يستغرق الأمر سنوات لتهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية سلام جادة بعد هذه الحرب الرهيبة. ومع ذلك، فإن الصراع وتداعياته الإقليمية هي تذكير صارخ بأنه على الرغم من أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس السبب الوحيد، إلا أن الاستقرار الإقليمي سيكون في خطر مستمر طالما استمر الصراع. وتدرك حكومات المنطقة بشكل متزايد أنها لا تستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة وحدها لتوفير عملية سلام قابلة للاستمرار لها.
خصوم أم جيران
حتى وإن كانت الحرب في غزة قد أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة الدولية، إلا أنها أبرزت الديناميكيات السياسية الجديدة المهمة التي تلعب في الشرق الأوسط. فمن ناحية، يبدو أن تأثير الولايات المتحدة قد تراجع من ناحية أخرى. ولكن في الوقت نفسه، تأخذ القوى الإقليمية، بما فيها تلك التي كانت على خلاف في السابق، زمام المبادرة، وتشارك في الوساطة، وتنسق استجاباتها السياسية. فبينما كانت القوى الإقليمية قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ولا سيما مصر والأردن وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، أقل اصطفافًا بشأن القضية الفلسطينية، فإنها تتصرف الآن بوحدة وتنسيق وتخطيط مثير للإعجاب. ولكن لتحويل هذا التصميم المشترك إلى مصدر دائم للقيادة الجماعية، يجب على هذه القوى أن تتبنى مؤسسات وترتيبات إقليمية أكثر ديمومة، والأهم من ذلك، يجب أن تشمل هذه الترتيبات منتدى حوار دائم للمنطقة بأسرها.
لا شك أن القمم العرضية للوزراء والتجمعات “المصغرة” المخصصة مثل منتدى غاز شرق المتوسط ومنتدى غاز شرق المتوسط والاتحاد الدولي الثاني للغاز ستستمر في تحديد المشهد الإقليمي في السنوات المقبلة، ولكن لا يوجد في هذه المنطقة منتدى دائم للأمن الإقليمي.
في أجزاء أخرى من العالم، تمكنت منتديات الأمن التعاوني، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورابطة دول جنوب شرق آسيا، من التطور إلى جانب التحالفات الأمنية الثنائية والإقليمية، مما عزز التواصل حتى بين الخصوم وساعد على منع نشوب الصراعات. ولا يوجد سبب لأن يظل الشرق الأوسط هو الاستثناء العالمي. وبالنظر إلى حاجة المنطقة الملحة للتنسيق وتهدئة الأوضاع، فإن الأزمة الحالية توفر فرصة حاسمة لبدء مثل هذه المبادرة.
وعلى الرغم من أن القادة كانوا متشككين بشأن فكرة إنشاء منتدى يضم المنطقة بأسرها، إلا أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها بناء آليات أمنية تعاونية جديدة. على سبيل المثال، منذ إطلاق عملية السلام في مدريد في أوائل التسعينيات لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تم اقتراح مثل هذه الترتيبات بشكل غير رسمي في حوارات بين الخبراء. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أوضح العديد من صانعي السياسات وغيرهم أن هذا النهج ناضج للتطبيق على المستوى الرسمي. وعلى الرغم من أن مثل هذا المنتدى يجب أن يهدف في نهاية المطاف إلى أن يشمل المنطقة بأكملها – جميع الدول العربية وإيران وإسرائيل وتركيا – إلا أن ذلك لن يكون ممكناً على الفور. ولكن يمكن لعدد أقل من الدول الرئيسية أن يبدأ عملية رسمية، مما يفتح المجال لمشاركة أوسع في المستقبل. وبما أن العديد من الدول العربية وتركيا لديها علاقات مع كل من إسرائيل وإيران، فإن مشاركتها ستكون ذات قيمة خاصة في البداية.
وينبغي أن تركز المنظمة الجديدة -التي يمكن تسميتها بمنتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتشمل أوسع فهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-، في البداية على القضايا الشاملة التي يوجد توافق واسع النطاق حولها، مثل المناخ والطاقة والاستجابات الطارئة للأزمات. وعلى الرغم من أنّ حل حرب غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيحتاج على الأرجح إلى أن يتم من خلال مبادرة عربية منفصلة، إلا أن المنتدى يمكن أن ينسق المواقف بشأن غزة ما بعد الحرب من خلال جدول أعمال الاستجابة الطارئة بما في ذلك الدعم الإنساني والمساعدات لإعادة إعمار الفلسطينيين،
لن يتوسط المنتدى بنفسه في النزاعات بشكل مباشر: فقد أثبتت الحوارات الأمنية التعاونية فعاليتها القصوى عندما تركز على تحسين التواصل والتنسيق لنزع فتيل التوترات وعلى توفير المنافع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية المتبادلة للأعضاء. ولكن من خلال الاتصالات المنتظمة والبناء التدريجي للثقة، يمكن لمثل هذه العملية أن تدعم حل النزاعات في الساحة الإسرائيلية الفلسطينية وخارجها.
وبالفعل، يمكن للاجتماعات الإقليمية الدائمة أن توفر فرصاً مهمة، ناهيك عن الغطاء السياسي، لإجراء حوارات حول النزاعات الخلافية بين الخصوم والأعداء الذين يفتقرون إلى قنوات اتصال مباشرة. ويمكن أن يشمل ذلك ليس فقط الإسرائيليين والفلسطينيين، بل أيضًا الإسرائيليين والإيرانيين في نهاية المطاف، الذين يمكن أن يجتمعوا في مجموعات عمل فنية حول القضايا غير الخلافية ذات الاهتمام المشترك. وقد تكشفت بالفعل مثل هذه التفاعلات بهدوء على هامش منتديات أخرى متعددة الأطراف تركز على المناخ والمياه، مما يشير إلى أن التعاون الإقليمي الأكثر شمولاً ممكن في نهاية المطاف.
سيتطلب إنشاء منتدى للأمن في الشرق الأوسط إرادة سياسية على أعلى المستويات، بالإضافة إلى وجود نصير إقليمي قوي يعتبر طرفاً محايداً. أحد الاحتمالات هو الإعلان عن المنظمة الجديدة في اجتماع لوزراء الخارجية، ربما على هامش تجمع إقليمي آخر، مثل إحدى الجلسات الاقتصادية التي عقدت في البحر الميت في الأردن.
ومن المرجح أن تنجح المبادرة إذا تم إنشاؤها وقيادتها من داخل المنطقة. فعلى سبيل المثال، يمكن للقوى الوسطى في آسيا وأوروبا أن تقدم الدعم السياسي والتقني في المجالات التي قد تكون لديها فيها خبرات قيّمة. وعلى الأقل في البداية، يجب أن يكون للصين وروسيا والولايات المتحدة أدوار محدودة لمنع تحول المنتدى إلى منصة أخرى لتنافس القوى العظمى. ومع ذلك، سيكون دعم كل من واشنطن وبكين أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن يصبح المنتدى مكملاً مفيدًا لدبلوماسيتهما في المنطقة وليس تهديدًا لها.
وقت القيادة
من بين الحقائق الصعبة التي كشفتها الحرب في غزة، قد تكون إحدى الحقائق الصارخة هي حدود القوة الأمريكية. فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد تكون قادرة على توفير القيادة الحاسمة أو النفوذ اللازمين للدفع بتسوية إسرائيلية فلسطينية دائمة، إلا أنه من غير المرجح أن تقوم بذلك، وسيكون الأمر متروكًا لقادة الشرق الأوسط ودبلوماسييه لتولي زمام الأمور. ومن خلال استحواذها على اهتمام المنطقة وطاقتها الدبلوماسية، وفرت الحرب فرصة نادرة لأشكال جديدة من القيادة التعاونية.
لا يمكن لمنتدى أمني إقليمي أن يحقق السلام في الشرق الأوسط بمفرده – لا يمكن لمبادرة واحدة أن تفعل ذلك-، وبدون حوكمة مسؤولة سيظل الاستقرار الحقيقي طويل الأمد بعيد المنال. كما أن منظمة كهذه لن تحل محل كل توازن القوى التنافسي الذي لطالما كان سمة مميزة لفن إدارة الدولة في الشرق الأوسط. فحتى في آسيا وأوروبا، لم تحل الترتيبات التعاونية محل التنافسات الاستراتيجية الوطنية ولم تستطع أن تمنع المواجهة العسكرية، كما أظهرت الحرب في أوكرانيا بشكل مؤلم.
ومع ذلك، فإن وجود منتدى منتظم من شأنه أن يضيف طبقة حاسمة من الاستقرار إلى الشرق الأوسط المعرض للصراعات. كما أن مثل هذا المشروع يزداد إلحاحًا.
وعلى الرغم من أن السابع من أكتوبر لم يعكس بعد جميع التيارات الإقليمية التي تفضل التهدئة والتوافق، إلا أن الوقت قد يكون قد بدأ ينفد للاستفادة من إعادة ضبط الأوضاع. يجب على الدول العربية القيادية، إلى جانب القوى الإقليمية مثل تركيا، أن تغتنم الفرصة لتثبيت بعض التقارب الذي سبق غزة والتنسيق الذي نشأ منذ ذلك الحين. فالشرق الأوسط على مفترق طرق دقيق، إما أن يصاب بالشلل بسبب إراقة الدماء المروعة في غزة، وينزلق أكثر فأكثر إلى الأزمة والصراع، أو أن يبدأ في بناء مستقبل مختلف.
عن المؤلفين:
“داليا داسه كايي”: زميلة أولى في مركز بيركل للعلاقات الدولية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس و باحثة زائرة في برنامج فولبرايت شومان في جامعة لوند.
“سانام فاكيل”: مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس.
مركز #كاندل للدراسات