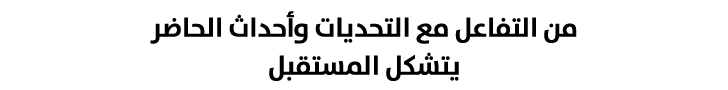عودة السلام من خلال القوة.. الدفاع عن سياسة ترامب الخارجية
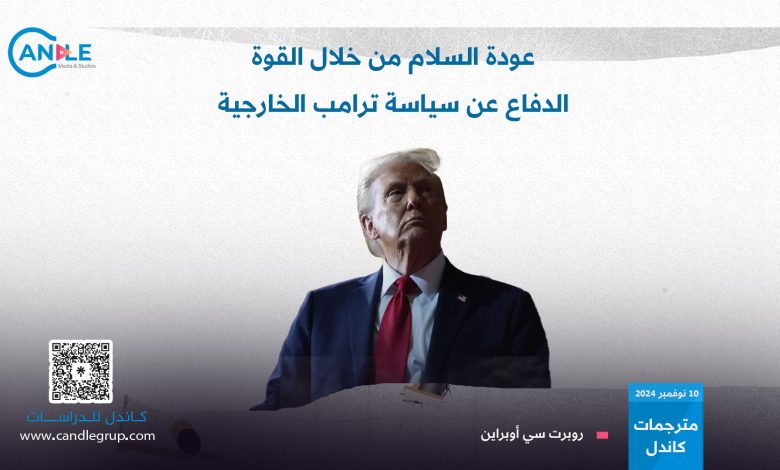
بقلم روبرت سي أوبراين
عودة للسلام من خلال القوة هي عبارة لاتينية ظهرت في القرن الرابع تعني “إذا كنت تريد السلام، فاستعد للحرب”. يعود أصل المفهوم إلى أبعد من ذلك، إلى الإمبراطور الروماني هادريان في القرن الثاني، والذي ينسب إليه البديهية، “السلام من خلال القوة – أو ، في حالة فشل ذلك ، السلام من خلال التهديد”.
وقد فهم الرئيس الأميركي جورج واشنطن ذلك جيدا. وقال للكونغرس في عام 1793: “إذا كنا نرغب في تأمين السلام، وهو أحد أقوى أدوات ازدهارنا الصاعد، فيجب أن يكون معروفا، أننا مستعدون في جميع الأوقات للحرب”. وقد ترددت أصداء الفكرة في مقولة الرئيس ثيودور روزفلت الشهيرة: “تحدث بهدوء، واحمل عصا كبيرة”. وكمرشح للرئاسة، استعار رونالد ريغان مباشرة من هادريان عندما وعد بتحقيق “السلام من خلال القوة”، ثم أوفى بهذا الوعد في وقت لاحق.
في عام 2017 ، أعاد الرئيس دونالد ترامب هذه الروح إلى البيت الأبيض بعد عهد أوباما ، حيث كان للولايات المتحدة رئيس شعر أنه من الضروري الاعتذار عن الخطايا المزعومة للسياسة الخارجية الأمريكية واستنزف قوة الجيش الأمريكي. انتهى ذلك عندما تولى ترامب منصبه. وكما أعلن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2020، فإن الولايات المتحدة “تحقق مصيرها كصانعة سلام، لكنها السلام من خلال القوة”.
وكان ترامب صانع سلام – وهي حقيقة تحجبها الصور الكاذبة له، ولكنها واضحة تماما عندما ينظر المرء إلى السجل. في الأشهر ال 16 الأخيرة فقط من إدارته، سهلت الولايات المتحدة اتفاقيات إبراهيم، وجلبت السلام إلى إسرائيل وثلاثة من جيرانها في الشرق الأوسط بالإضافة إلى السودان. وافقت صربيا وكوسوفو على التطبيع الاقتصادي بوساطة أمريكية. نجحت واشنطن في دفع مصر ودول الخليج الرئيسية لتسوية خلافها مع قطر وإنهاء حصارها. وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقا مع طالبان لمنع أي استهدف الجنود الأمريكان في أفغانستان طوال العام الأخير تقريبا من إدارة ترامب.
كان ترامب مصمما على تجنب حروب جديدة وعمليات مكافحة تمرد لا نهاية لها ، وكانت رئاسته هي الأولى منذ رئاسة جيمي كارتر التي لم تدخل فيها الولايات المتحدة حربا جديدة أو توسع صراعا قائما. كما أنهى ترامب حربا واحدة بانتصار أمريكي نادر ، حيث قضى على تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش) كقوة عسكرية منظمة وقضى على زعيمه أبو بكر البغدادي.
ولكن على عكس فترة ولاية كارتر، في عهد ترامب، لم يستغل خصوم الولايات المتحدة تفضيل الأمريكيين للسلام. في سنوات ترامب، لم تتقدم روسيا أكثر بعد غزوها لأوكرانيا عام 2014، ولم تجرؤ إيران على مهاجمة إسرائيل مباشرة، وتوقفت كوريا الشمالية عن اختبار الأسلحة النووية بعد مزيج من التواصل الدبلوماسي واستعراض القوة العسكرية الأمريكية. وعلى الرغم من أن الصين حافظت على موقف عدواني خلال فترة ترامب في منصبه، إلا أن قيادتها لاحظت بالتأكيد تصميم ترامب على فرض خطوط حمراء عندما أمر، على سبيل المثال، بشن هجوم جوي محدود ولكنه فعال على سوريا في عام 2017، بعد أن استخدم نظام بشار الأسد الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.
ستشهد ولاية ترامب الثانية عودة الواقعية بنكهة جاكسونية.
لم يطمح ترامب أبدا إلى نشر “عقيدة ترامب” لصالح مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن. إنه لا يلتزم بالعقيدة بل بغرائزه الخاصة والمبادئ الأمريكية التقليدية التي هي أعمق من الأرثوذكسية العالمية في العقود الأخيرة. “أمريكا أولا ليست أمريكا وحدها” هو شعار غالبا ما يكرره مسؤولو إدارة ترامب، ولسبب وجيه: يدرك ترامب أن السياسة الخارجية الناجحة تتطلب توحيد القوى مع الحكومات الصديقة والشعوب في أماكن أخرى. حقيقة أن ترامب ألقى نظرة جديدة على البلدان والمجموعات الأكثر صلة لا تجعله مجرد معاملات أو انعزالية معادية للتحالفات ، كما يدعي منتقدوه. تم تعزيز تعاون الناتو والولايات المتحدة مع اليابان وإسرائيل ودول الخليج العربي عسكريا عندما كان ترامب رئيسا.
يمكن فهم سياسة ترامب الخارجية والسياسة التجارية بدقة كرد فعل على أوجه القصور في الأممية النيوليبرالية ، أو العولمة ، كما تمارس من أوائل تسعينيات القرن العشرين حتى عام 2017. مثل العديد من الناخبين الأمريكيين، أدرك ترامب أن “التجارة الحرة” لم تكن شيئا من هذا القبيل في الممارسة العملية، وفي كثير من الحالات شملت الحكومات الأجنبية استخدام التعريفات الجمركية العالية، والحواجز أمام التجارة، وسرقة الملكية الفكرية للإضرار بالمصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية. وعلى الرغم من الإنفاق العسكري الضخم، حقق جهاز الأمن القومي في واشنطن انتصارات قليلة بعد حرب الخليج عام 1991، بينما عانى من عدد من الإخفاقات الملحوظة في أماكن مثل العراق وليبيا وسوريا.
يفكر ترامب بشدة في نهج سلفه أندرو جاكسون وجاكسون في السياسة الخارجية: كن مركزا وقويا عندما تضطر إلى العمل ولكن حذرا من التجاوز. ستشهد ولاية ترامب الثانية عودة الواقعية بنكهة جاكسونية. سيكون أصدقاء واشنطن أكثر أمانا وأكثر اعتمادا على الذات، وسيخشى خصومها مرة أخرى القوة الأمريكية. ستكون الولايات المتحدة قوية، وسيكون هناك سلام.
ماذا حدث؟
في أوائل تسعينيات القرن العشرين ، بدا العالم على أعتاب “القرن الأمريكي” الثاني. سقط الستار الحديدي ، وصرفت دول أوروبا الشرقية الشيوعية وتخلت عن حلف وارسو ، واصطفت للانضمام إلى أوروبا الغربية وبقية العالم الحر. دخل الاتحاد السوفيتي التاريخ في عام 1991. وبدا أن الرافضين لتيار الحرية، مثل الصين، على وشك التحرر، على الأقل اقتصاديا، ولم يشكلوا أي تهديد وشيك للولايات المتحدة. أثبتت حرب الخليج صحة الحشد العسكري الأمريكي في العقد الماضي وساعدت في تأكيد أن العالم كان لديه قوة عظمى واحدة فقط.
قارن هذا الوضع باليوم. لقد أصبحت الصين خصما عسكريا واقتصاديا هائلا. إنه يهدد تايوان الديمقراطية بشكل روتيني. ويمر خفر السواحل والميليشيات البحرية بحكم الأمر الواقع بحالة طويلة من الصراع منخفض الحدة مع الفلبين حليف الولايات المتحدة في المعاهدة مما قد يشعل حربا أوسع في بحر الصين الجنوبي. بكين هي الآن العدو الأول لواشنطن في الفضاء الإلكتروني، وتهاجم بانتظام شبكات الأعمال والحكومة الأمريكية. لقد أضرت الممارسات التجارية والتجارية غير العادلة للصين بالاقتصاد الأمريكي وجعلت الولايات المتحدة تعتمد على الصين في السلع المصنعة وحتى بعض الأدوية الأساسية. وعلى الرغم من أن نموذج الصين لا يشبه الجاذبية الإيديولوجية لثوار العالم الثالث والراديكاليين الغربيين التي احتفظت بها الشيوعية السوفيتية في منتصف القرن العشرين، إلا أن القيادة السياسية الصينية تحت قيادة شي جين بينغ كانت تتمتع بالثقة الكافية لعكس الإصلاحات الاقتصادية، وسحق الحرية في هونغ كونغ، والدخول في معارك مع واشنطن والعديد من شركائها. شي هو أخطر زعيم للصين منذ ماو تسي تونغ القاتل. ولم تحاسب الصين بعد على جائحة كوفيد-19، التي نشأت في ووهان.
ولدى الصين الآن شريك صغير ملتزم ومفيد في موسكو أيضا. في عام 2018 ، بعد عام من ترك منصبه كنائب للرئيس ، شارك جو بايدن في تأليف مقال في هذه الصفحات بعنوان “كيف تقف في وجه الكرملين”. لكن الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022 أظهر أن موسكو بالكاد ردعها حديثه القاسي. كما كشفت الحرب الحقيقة المخزية المتمثلة في أن أعضاء الناتو الأوروبيين غير مستعدين لبيئة قتالية جديدة تجمع بين التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار منخفضة التقنية ولكنها قاتلة والمدفعية التي يبلغ عمرها قرنا من الزمان.
تنضم إيران إلى الصين وروسيا في محور ناشئ من الأنظمة الاستبدادية المناهضة لأمريكا. ومثل النظامين في بكين وموسكو، أصبحت الثيوقراطية في طهران أكثر جرأة. ومع الإفلات من العقاب على ما يبدو، كثيرا ما يهدد قادتها الولايات المتحدة وحلفائها. لقد جمعت إيران الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب لبناء سلاح نووي أساسي في أقل من أسبوعين، إذا اختارت القيام بذلك، وفقا لأكثر التقديرات موثوقية. وكلاء إيران، بما في ذلك حماس، يختطفون ويقتلون الأمريكيين. وفي نيسان/أبريل، وللمرة الأولى، هاجمت إيران أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط، إسرائيل، مباشرة من الأراضي الإيرانية، وأطلقت مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ.
الصورة الأقرب إلى المنزل ليست أفضل. في المكسيك ، تشكل عصابات المخدرات حكومة موازية في بعض المناطق وتتاجر بالأشخاص والمخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة. فنزويلا هي حالة سلة حربية. وربما يكون عجز إدارة بايدن عن تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة هو فشلها الأكبر والأكثر إحراجا.
الوضوح بشأن الصين
هذا المستنقع من الضعف والفشل الأمريكي يصرخ من أجل استعادة ترامب للسلام من خلال القوة. ولا يوجد مكان أكثر إلحاحا من هذه الحاجة في المنافسة مع الصين.
منذ بداية ولايته الرئاسية ، أرسل بايدن رسائل مختلطة حول التهديد الذي تشكله بكين. على الرغم من أن بايدن احتفظ بالتعريفات الجمركية وضوابط التصدير التي سنها ترامب ، فقد أرسل أيضا مسؤولين على المستوى الوزاري في سلسلة من الزيارات إلى بكين ، حيث قدموا تحذيرات حازمة بشأن التجارة والأمن ، لكنهم مدوا أيضا غصن الزيتون ، واعدين باستعادة بعض أشكال التعاون مع الصين التي كانت موجودة قبل إدارة ترامب. هذه هي سياسة المهرجانات على الجوهر. الاجتماعات ومؤتمرات القمة هي أنشطة وليست إنجازات.
وفي الوقت نفسه، تولي بكين اهتماما وثيقا لما يقوله الرئيس وكبار مستشاريه علنا. أشار بايدن إلى الاقتصاد الصيني على أنه “قنبلة موقوتة” لكنه قال أيضا بوضوح ، “لا أريد احتواء الصين” و “نحن لا نتطلع إلى إيذاء الصين – بصدق. سنكون جميعا أفضل حالا إذا أبلت الصين بلاء حسنا”. إن تصديق مثل هذا الخداع يعني الاعتقاد بأن الصين ليست خصما حقيقيا.
يسعى الحزب الشيوعي الصيني إلى توسيع قوته وأمنه من خلال استبدال الولايات المتحدة كرائد عالمي في التطوير التكنولوجي والابتكار في مجالات حيوية مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية. للقيام بذلك، تعتمد بكين على الإعانات الهائلة، وسرقة الملكية الفكرية، والممارسات التجارية غير العادلة. في صناعة السيارات، على سبيل المثال، دعمت بكين أبطالا وطنيين مثل BYD، التي أمطرتها بالإعانات وشجعتها على إغراق ملايين السيارات الكهربائية الرخيصة في الأسواق في الولايات المتحدة والدول الحليفة، بهدف إفلاس شركات صناعة السيارات من سيول إلى طوكيو إلى ديترويت إلى بافاريا.
وللحفاظ على ميزتها التنافسية في مواجهة هذا الهجوم، يجب أن تظل الولايات المتحدة أفضل مكان في العالم للاستثمار والابتكار والقيام بأعمال تجارية. لكن السلطة المتزايدة للدولة التنظيمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك إنفاذ مكافحة الاحتكار بشكل مفرط، تهدد بتدمير النظام الأمريكي للمشاريع الحرة. حتى في الوقت الذي تتلقى فيه الشركات الصينية دعما غير عادل من بكين لإخراج الشركات الأمريكية من العمل ، فإن حكومات الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين يجعلون من الصعب على تلك الشركات الأمريكية نفسها المنافسة. وهذه وصفة للانحدار الوطني. يجب على الحكومات الغربية التخلي عن هذه اللوائح غير الضرورية.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى تقويض القوة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، يجب على واشنطن أن ترد الجميل – تماما كما فعلت خلال الحرب الباردة، عندما عملت على إضعاف الاقتصاد السوفيتي. قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن “الانفصال الاقتصادي الكامل [عن الصين] ليس عمليا ولا مرغوبا فيه” وأن الولايات المتحدة “ترفض فكرة أننا يجب أن نفصل اقتصادنا عن الصين”. لكن يجب على واشنطن، في الواقع، أن تسعى إلى فصل اقتصادها عن اقتصاد الصين. دون وصفها على هذا النحو ، بدأ ترامب سياسة فعلية للفصل من خلال سن تعريفات أعلى على حوالي نصف الصادرات الصينية إلى أمريكا ، تاركا لبكين خيار استئناف التجارة الطبيعية إذا غيرت سلوكها – وهي فرصة لم تغتنمها. الآن هو الوقت المناسب للضغط أكثر من ذلك، مع تعريفة بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، كما دعا ترامب، وضوابط تصدير أكثر صرامة على أي تكنولوجيا قد تكون مفيدة للصين.
وبطبيعة الحال، يجب على واشنطن أن تبقي خطوط اتصال مفتوحة مع بكين، ولكن يجب على الولايات المتحدة أن تركز دبلوماسيتها في المحيط الهادئ على حلفاء مثل أستراليا واليابان والفلبين وكوريا الجنوبية، والشركاء التقليديين مثل سنغافورة، والشركاء الناشئين مثل إندونيسيا وفيتنام. ويشير النقاد إلى أن دعوات ترامب لحلفاء الولايات المتحدة في آسيا للمساهمة بشكل أكبر في الدفاع عن أنفسهم قد تقلقهم. على العكس من ذلك، كشفت مناقشاتي مع المسؤولين في المنطقة أنهم سيرحبون بالمزيد من حديث ترامب الواضح حول الحاجة إلى أن تكون التحالفات علاقات ثنائية الاتجاه وأنهم يعتقدون أن نهجه سيعزز الأمن.
إن المصدر الحقيقي للاضطرابات في الشرق الأوسط هو النظام الديني الإيراني.
والمناورات العسكرية المشتركة مع هذه البلدان ضرورية. ألغى ترامب دعوة الصين من المناورات الحربية السنوية لحافة المحيط الهادئ في عام 2018: الفريق الدفاعي الجيد لا يدعو خصمه الأكثر احتمالا لمشاهدة التخطيط والممارسة. (الصين ، بطبيعة الحال ، أرسلت سفن تجسس للمراقبة). أشار الكونغرس في عام 2022 إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تدعو تايوان للانضمام إلى التدريبات. لكن بايدن رفض القيام بذلك – وهو خطأ يجب معالجته.
وتنفق تايوان نحو 19 مليار دولار سنويا على دفاعها، وهو ما يعادل أقل بقليل من ثلاثة في المئة من ناتجها الاقتصادي السنوي. وعلى الرغم من أن هذا أفضل من معظم حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، إلا أنه لا يزال قليلا جدا. وتحتاج بلدان أخرى في هذه المنطقة المتزايدة الخطورة أيضا إلى إنفاق المزيد. وقصر تايوان ليس خطأها وحدها: فقد أرسلت الإدارات الأمريكية السابقة إشارات متضاربة حول استعداد واشنطن لتزويد تايوان بالأسلحة والمساعدة في الدفاع عنها. يجب على الإدارة القادمة أن توضح أنه إلى جانب الالتزام الأمريكي المستمر يأتي توقع أن تنفق تايوان المزيد على الدفاع وأن تتخذ خطوات أخرى أيضا، مثل توسيع التجنيد العسكري.
وفي الوقت نفسه، يجب على الكونغرس أن يساعد في بناء القوات المسلحة لإندونيسيا والفلبين وفيتنام من خلال تقديم أنواع المنح والقروض وعمليات نقل الأسلحة التي طالما عرضتها الولايات المتحدة على إسرائيل. وتحتاج الفلبين بشكل خاص إلى دعم سريع في مواجهتها مع القوات الصينية في بحر الصين الجنوبي. يجب على البحرية تنفيذ برنامج مكثف لتجديد السفن التي خرجت من الخدمة ثم التبرع بها للفلبين ، بما في ذلك الفرقاطات والسفن الهجومية البرمائية الموجودة في الاحتياط في فيلادلفيا وهاواي.
يجب على البحرية أيضا نقل إحدى حاملات طائراتها من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ ، ويجب على البنتاغون النظر في نشر سلاح مشاة البحرية بأكمله في المحيط الهادئ ، وإعفائه بشكل خاص من المهام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غالبا ما تفتقر القواعد الأمريكية في المحيط الهادئ إلى الدفاعات الصاروخية الكافية وحماية الطائرات المقاتلة – وهو نقص فاضح يجب على وزارة الدفاع إصلاحه عن طريق تحويل الموارد بسرعة من مكان آخر.
عودة الضغط الأقصى
المنطقة الأخرى التي أظهرت فيها إدارة بايدن القليل من القوة وبالتالي لم تجلب سوى القليل من السلام هي الشرق الأوسط. دخل بايدن منصبه مصمما على نبذ المملكة العربية السعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان – ولكن أيضا لاستئناف سياسة عهد أوباما المتمثلة في التفاوض مع إيران ، وهي أسوأ منتهك لحقوق الإنسان. وقد أدى هذا النهج إلى نفور المملكة العربية السعودية، وهي شريك مهم ومصدر للطاقة، ولم يفعل شيئا لترويض إيران، التي أصبحت أكثر عنفا بشكل واضح في السنوات الأربع الماضية. رأى الحلفاء في الشرق الأوسط وخارجه هذه الإجراءات كدليل على ضعف الولايات المتحدة وعدم موثوقيتها واتبعوا سياسات خارجية أكثر استقلالية عن واشنطن. لقد شعرت إيران نفسها بالحرية في مهاجمة إسرائيل والقوات الأمريكية والشركاء الأمريكيين من خلال وكلاء وبشكل مباشر.
في المقابل، شنت إدارة ترامب حملة من الضغط الأقصى على إيران، بما في ذلك الإصرار على أن تمتثل الدول الأوروبية للعقوبات الأمريكية وعقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية. وقد حشد هذا العرض من العزم شركاء مهمين للولايات المتحدة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومهد الطريق لاتفاقيات إبراهيم. عندما يرى حلفاء الولايات المتحدة تصميما أمريكيا متجددا على احتواء النظام الإسلامي في طهران، سينضمون إلى واشنطن ويساعدون في إحلال السلام في منطقة حيوية لأسواق الطاقة وأسواق رأس المال العالمية.
لسوء الحظ، حدث العكس خلال إدارة بايدن، التي فشلت في فرض العقوبات الحالية على صادرات النفط الإيرانية. وفي الأشهر الأخيرة، وصلت هذه الصادرات إلى أعلى مستوى لها في ست سنوات، متجاوزة 1.5 مليون برميل يوميا. كان تخفيف تطبيق العقوبات بمثابة مكافأة للحكومة الإيرانية وجيشها ، حيث حقق لهم عشرات المليارات من الدولارات سنويا. إن استعادة حملة ترامب ستحد من قدرة إيران على تمويل القوات الإرهابية بالوكالة في الشرق الأوسط وخارجه.
بدأت مشاكل بايدن في الشرق الأوسط عندما حاول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني في عهد أوباما الذي انسحب منه ترامب في عام 2018 ،بعد أن اعترف بأنه فاشل. وبعيدا عن القضاء على البرنامج النووي الإيراني أو حتى تجميده، فقد قدسه الاتفاق، مما سمح لإيران بالاحتفاظ بأجهزة الطرد المركزي التي استخدمتها لجمع ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة. وستشمل العودة إلى سياسة ترامب المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط التطبيق الكامل للعقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني، وتطبيقها ليس فقط على إيران ولكن أيضا على الحكومات والمنظمات التي تشتري النفط والغاز الإيرانيين. وسيعني الضغط الأقصى أيضا نشر المزيد من الأصول البحرية والجوية في الشرق الأوسط، مما يوضح ليس فقط لطهران ولكن أيضا لحلفاء الولايات المتحدة أن تركيز الجيش الأمريكي في المنطقة كان على ردع إيران، متجاوزا أخيرا توجه مكافحة التمرد في العقدين الماضيين.
ومن شأن سياسة أقوى لمواجهة إيران أن تؤدي أيضا إلى نهج أكثر إنتاجية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي يعكر صفو المنطقة مرة أخرى. وعلى مدى عقود، كانت الحكمة التقليدية ترى أن حل هذا النزاع هو المفتاح لتحسين الأمن في الشرق الأوسط. لكن الصراع أصبح عرضا أكثر من كونه سببا للاضطرابات في المنطقة، ومصدرها الحقيقي هو النظام الثوري الثيوقراطي في إيران. وتوفر طهران التمويل والأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والتوجيه الاستراتيجي لمجموعة من الجماعات التي تهدد أمن إسرائيل – ليس فقط «حماس»، التي أشعلت الحرب الحالية في غزة بهجومها الوحشي على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ولكن أيضا منظمة «حزب الله» اللبنانية الإرهابية وميليشيا الحوثي في اليمن. لا يمكن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حتى يتم احتواء إيران – وحتى يتوقف المتطرفون الفلسطينيون عن محاولة القضاء على الدولة اليهودية.
وفي غضون ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في دعم إسرائيل في سعيها للقضاء على «حماس» في غزة. إن الحكم ووضع الإقليم على المدى الطويل ليسا من اختصاص واشنطن. يجب على الولايات المتحدة دعم إسرائيل ومصر وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج وهم يتعاملون مع هذه المشكلة. لكن يجب على واشنطن ألا تضغط على إسرائيل للعودة إلى المفاوضات حول حل طويل الأجل للصراع الأوسع مع الفلسطينيين. يجب أن يظل تركيز سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على الفاعل الحاقد الذي يتحمل في نهاية المطاف المسؤولية الأكبر عن الاضطرابات والقتل: النظام الإيراني.
من كابول إلى كييف
كما أضعف بايدن بشكل كبير فن الحكم الأمريكي من خلال سوء إدارته الكارثي للانسحاب من أفغانستان. تفاوضت إدارة ترامب على الصفقة التي أنهت تورط الولايات المتحدة في الحرب ، لكن ترامب لم يكن ليسمح أبدا بمثل هذا التراجع الفوضوي والمحرج. يمكن للمرء أن يرسم خطا مباشرا من عجز الانسحاب في صيف عام 2021 إلى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمهاجمة أوكرانيا بعد ستة أشهر. بعد أن تجاهلت روسيا تحذيرات بايدن بشأن عواقب غزو أوكرانيا وهاجمت على أي حال، عرض بايدن على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوسائل لمغادرة كييف، الأمر الذي كان سيكرر هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني المخزي من كابول في الصيف السابق. لحسن الحظ ، رفض زيلينسكي العرض.
ومنذ ذلك الحين، قدمت إدارة بايدن مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا، لكنها غالبا ما تباطأت في إرسال أنواع الأسلحة التي تحتاجها للنجاح. إن مبلغ 61 مليار دولار الذي خصصه الكونغرس مؤخرا لأوكرانيا – بالإضافة إلى 113 مليار دولار تمت الموافقة عليها بالفعل – ربما يكون كافيا لمنع أوكرانيا من الخسارة ، ولكنه ليس كافيا لتمكينها من الفوز. وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن بايدن لديه خطة لإنهاء الحرب.
من جانبه، أوضح ترامب أنه يود أن يرى تسوية تفاوضية للحرب تنهي القتل وتحافظ على أمن أوكرانيا. يتمثل نهج ترامب في الاستمرار في تقديم المساعدات الفتاكة لأوكرانيا، بتمويل من الدول الأوروبية، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية مع روسيا، وإبقاء موسكو غير متوازنة بدرجة من عدم القدرة على التنبؤ. كما سيدفع الناتو إلى تناوب القوات البرية والجوية على بولندا لزيادة قدراتها بالقرب من الحدود الروسية وتوضيح أن الحلف سيدافع عن جميع أراضيه من العدوان الأجنبي.
يجب على واشنطن التأكد من أن حلفاءها الأوروبيين يفهمون أن الدفاع الأمريكي المستمر عن أوروبا يتوقف على قيام أوروبا بدورها – بما في ذلك في أوكرانيا. وإذا كانت أوروبا راغبة في إظهار جديتها في الدفاع عن أوكرانيا، فيتعين عليها أن تقبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي على الفور، وأن تتنازل عن بروتوكول الانضمام البيروقراطي المعتاد. ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تبعث برسالة قوية إلى بوتين مفادها أن الغرب لن يتنازل عن أوكرانيا لموسكو. كما أنه سيعطي الأمل للشعب الأوكراني بأن أياما أفضل تنتظرنا.
جيش في تراجع
مع صعود الصين، واحتراق الشرق الأوسط، وتفشي روسيا في أوكرانيا، استأنف الجيش الأمريكي التراجع التدريجي الذي بدأ خلال إدارة أوباما قبل أن يتوقف خلال فترة ترامب في منصبه. في العام الماضي ، حقق سلاح مشاة البحرية وقوة الفضاء فقط أهداف التجنيد. انخفض الجيش بمقدار مذهل بلغ 10000 مجند عن هدفه المتواضع المتمثل في إضافة 65000 جندي للحفاظ على حجمه الحالي. والعجز ليس مجرد مشكلة تتعلق بالموظفين؛ بل هو أيضا مشكلة تتعلق بالموظفين. إنه يتحدث عن عدم ثقة الشباب الأمريكيين وعائلاتهم في هدف ومهمة الجيش.
وفي الوقت نفسه، يفتقر الجيش بشكل متزايد إلى الأدوات التي يحتاجها للدفاع عن الولايات المتحدة ومصالحها. تمتلك البحرية الآن أقل من 300 سفينة ، مقارنة ب 592 في نهاية إدارة ريغان. وهذا لا يكفي للحفاظ على الردع التقليدي من خلال الوجود البحري في 18 منطقة بحرية في العالم والتي حددها القادة المقاتلون الأمريكيون على أنها ذات أهمية استراتيجية. يجب على الكونغرس والسلطة التنفيذية إعادة الالتزام بهدف امتلاك بحرية من 355 سفينة بحلول عام 2032 ، وهو ما حدده ترامب في عام 2017. يجب أن تتضمن هذه البحرية الأكبر حجما بشكل متواضع المزيد من الغواصات الهجومية الشبحية من فئة فرجينيا. ومن الأمور الحاسمة أيضا المزيد من غواصات الصواريخ الباليستية من طراز كولومبيا، والتي تشكل جزءا مما يسمى بالثالوث النووي – المعدات والأنظمة التي تسمح لواشنطن بنشر أسلحة نووية من الجو والبر والبحر.
أجزاء أخرى من الثالوث تحتاج إلى تحسين أيضا. على سبيل المثال ،يجب على الكونجرس تخصيص الأموال لجميع الوحدات ال 100 المخطط لها من القاذفة الشبح B-21 قيد التطوير ، لتحل محل قاذفة B-2 القديمة. في الواقع ، جادل بعض المحللين بأن القوات الجوية تحتاج إلى ما لا يقل عن 256 من هذه القاذفات الضاربة المخترقة لتنفيذ حملة مستدامة ضد منافس نظير. لتجنب مشاكل الشراء التي واجهتها B-2 ، والتي تركت سلاح الجو بأسطول من 21 طائرة فقط بدلا من 132 طائرة مخطط لها في الأصل ، يجب على كل من القوات الجوية ولجان الكونجرس المناسبة العمل لضمان عملية إنتاج مستقرة.
أصبح الثالوث أكثر أهمية في السنوات الأخيرة حيث قامت الصين وروسيا بتحديث ترساناتهما النووية. لقد ضاعفت الصين حجم ترسانتها منذ عام 2020: توسع هائل وغير مبرر وغير مبرر. يتعين على الولايات المتحدة الحفاظ على التفوق التقني والعددي على المخزونات النووية الصينية والروسية مجتمعة. وللقيام بذلك، يجب على واشنطن اختبار أسلحة نووية جديدة للتأكد من موثوقيتها وسلامتها في العالم الحقيقي لأول مرة منذ عام 1992 – وليس فقط باستخدام نماذج الكمبيوتر. وإذا استمرت الصين وروسيا في رفض الدخول في محادثات الحد من التسلح بحسن نية، ينبغي على الولايات المتحدة أيضا استئناف إنتاج اليورانيوم-235 والبلوتونيوم-239، وهما النظيران الانشطاريان الرئيسيان للأسلحة النووية.
تحتاج الترسانة التقليدية الأمريكية أيضا إلى التحول. أحيت إدارة ترامب تطوير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ، والتي خفض تمويلها الرئيس باراك أوباما بشكل كبير في عام 2011 ، تاركة الصين وروسيا متقدمتين بفارق كبير على الولايات المتحدة في الحصول على هذه الأسلحة الجديدة المهمة التي تنتقل بسرعة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت ويمكنها المناورة داخل الغلاف الجوي للأرض. ستشهد ولاية ترامب الثانية استثمارات ضخمة في هذه التكنولوجيا الحيوية.
ستتطلب استعادة الجيش مشاركة نشطة من الرئيس وقيادة الكونغرس لأن الأفراد المدنيين والنظاميين غير قادرين على إصلاح البنتاغون بأنفسهم. (غالبا ما دفع ترامب من أجل الابتكار في مواجهة الجمود البيروقراطي الذي يعززه كبار المسؤولين المدنيين في وزارة الدفاع). لكن التغيير الجوهري يجب أن يأخذ في الحسبان واقع الميزانيات المحدودة. وبفضل مستويات الاقتراض غير المستدامة، سيتعين على الميزانية الفيدرالية أن تنخفض، ومن غير المرجح حدوث زيادات كبيرة في نفقات الدفاع بغض النظر عن الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض والكونغرس. والإنفاق الأكثر ذكاء يجب أن يحل محل الإنفاق أكثر في استراتيجية معاصرة للسلام من خلال القوة.
يتطلب إصلاح الجيش إصلاحات كبيرة في عمليات الاستحواذ على القوات المسلحة، سواء بالنسبة له أو للجيوش المتحالفة معه. في العقود الأخيرة ، وصلت مشاريع مهمة مثل مدمرة Zumwalt ، والسفينة القتالية الساحلية ، ومقاتلة F-35 ، وطائرة الصهريج KC-46 متأخرة سنوات وتجاوزت الميزانية إلى حد كبير. في خمسينيات القرن العشرين ، على النقيض من ذلك ، سلمت شركة لوكهيد أول طائرة تجسس U-2 بعد أقل من عام ونصف من الحصول على العقد – وأكملت ذلك في إطار الميزانية. مثل هذا الإنجاز لا يمكن تصوره اليوم بسبب مواقف الوضع الراهن في معظم الخدمات ، والخلل الوظيفي في الكونجرس الذي يجعل الميزانية والتخطيط أمرا صعبا ، والافتقار إلى الرؤية من جانب وزراء القوات المسلحة.
مشكلة أساسية أخرى في المشتريات العسكرية هي نظام البنتاغون غير العقلاني لتطوير متطلبات الأسلحة الجديدة. المتطلبات سهلة الإضافة ويصعب إزالتها. والنتيجة هي أسلحة متطورة للغاية ، لكنها باهظة الثمن وتستغرق سنوات لنشرها. على سبيل المثال ، في أوائل ومنتصف تسعينيات القرن العشرين ، عندما كانت البحرية تصمم فئتها الحالية من حاملات الطائرات ، أضافت شرطا لنظام إطلاق الطائرات الكهرومغناطيسي – وهي تقنية لم تكن موجودة في ذلك الوقت. وأضاف القرار، الذي انتقده ترامب في عام 2017، تكاليف وتأخيرات كبيرة. يجب على القيادة المدنية العليا في البنتاغون إصلاح العملية من خلال وضع قاعدة جديدة مفادها أن أي تغيير كبير في التصميم قد يضيف تكلفة أو وقتا لتطوير الأنظمة الأساسية يجب أن يأذن به هم ومن قبلهم وحدهم.
يجب على الولايات المتحدة أن تستلهم من أنظمة المشتريات في حلفاء مثل أستراليا، حيث طورت بيروقراطية هزيلة مركبة جوية قتالية بدون طيار من طراز Ghost Bat ومركبة Ghost Shark غير المأهولة تحت الماء بتكلفة منخفضة وبدون تأخيرات هائلة تعيق المشتريات الأمريكية. كما يمكن لموردي الدفاع الجدد مثل أندوريل وبلانتير – الشركات المتجذرة في قطاع التكنولوجيا المبتكرة – أن يساعدوا البنتاغون على تطوير عمليات شراء أكثر ملاءمة للقرن الحادي والعشرين.
اعرف عدوك – وأصدقائك
ومع ذلك، فإن وجود جيش أكثر كفاءة وحده لن يكون كافيا لإحباط وردع محور بكين وموسكو وطهران الجديد. وسيتطلب القيام بذلك أيضا تحالفات قوية بين البلدان الحرة في العالم. سيكون بناء التحالفات بنفس أهمية ولاية ترامب الثانية كما كان في الولاية الأولى. على الرغم من أن النقاد غالبا ما صوروا ترامب على أنه معاد للتحالفات التقليدية ، إلا أنه في الواقع عزز معظمها. لم يلغ ترامب أو يؤجل أبدا عملية نشر واحدة في الناتو. إن ضغطه على حكومات الناتو لإنفاق المزيد على الدفاع جعل الحلف أقوى.
يحب مسؤولو إدارة بايدن التشدق بأهمية التحالفات، ويقول بايدن إنه يعتقد أن الولايات المتحدة منخرطة في منافسة تضع الديمقراطيات المتحالفة ضد الأنظمة الاستبدادية المتنافسة. لكن الإدارة تقوض مهمتها المفترضة عندما تشكك في النوايا الديمقراطية للقادة المحافظين المنتخبين في البلدان المتحالفة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس البولندي أندريه دودا. والواقع أن هؤلاء القادة يستجيبون لرغبات شعوبهم ويسعون إلى الدفاع عن الديمقراطية، ولكن من خلال سياسات مختلفة عن تلك التي يتبناها ذلك النوع من الناس الذين يحبون الانغماس في دافوس. ومع ذلك، تبدو إدارة بايدن أقل اهتماما بتعزيز العلاقات الجيدة مع الحلفاء الديمقراطيين في العالم الحقيقي من اهتمامها بالدفاع عن التجريدات الخيالية مثل “النظام الدولي القائم على القواعد”. ويعكس هذا الخطاب نخبوية ليبرالية عالمية تتنكر في هيئة دعم للمثل الديمقراطية.
إن انتقاد هؤلاء القادة الديمقراطيين هو أكثر إثارة للغضب عند مقارنته بمدى قلة الاهتمام الذي يوليه مسؤولو بايدن للمنشقين في الدول الاستبدادية. نادرا ما يتبع الرئيس وكبار مساعديه نهج الرؤساء السابقين الذين سلطوا الضوء على المعارضين المحتجزين لتوضيح الانتهاكات الاستبدادية وتسليط الضوء على تفوق نموذج العالم الحر للحقوق الفردية غير القابلة للتصرف وسيادة القانون. كتب كارتر شخصيا إلى المنشق السوفيتي أندريه ساخاروف. التقى ريغان مع المنشق السوفيتي ناتان شارانسكي في المكتب البيضاوي والتقى بآخرين في السفارة الأمريكية في موسكو. في المقابل، نادرا ما تحدث بايدن علنا عن المنشقين الأفراد – أشخاص مثل جيمي لاي، الناشر في هونغ كونغ والمدافع عن الديمقراطية الذي سجنه المسؤولون الصينيون بتهم زائفة. وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية أصدرت احتجاجات على معاملة الصين لمواطنيها، إلا أنها جاءت على خلفية مشاركة رفيعة المستوى وغير مشروطة مع الصين لا تتضمن أي عنصر جاد لحقوق الإنسان.
ضغط ترامب على حكومات الناتو لإنفاق المزيد على الدفاع جعل الحلف أقوى.
من جانبه، فضل ترامب التركيز بشكل أكبر على الأمريكيين المحتجزين ظلما في الخارج بدلا من التركيز على المعارضين، في محاولة لبناء علاقات مع القادة الأجانب وإعطاء الديكتاتوريين مثل كيم جونغ أون في كوريا الشمالية فرصة للخروج من البرد. لكنه اهتم بقوى المعارضة في الدول الاستبدادية التي هي منافس للولايات المتحدة. في كانون الثاني/يناير 2020، بعد أن أعربت علنا عن أملي في أن يتمكن الشعب الإيراني يوما ما من اختيار قادته، تابع ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا تقتلوا المتظاهرين”، كما نصح الثيوقراطيين في طهران. وستشهد ولاية ترامب الثانية زيادة الاهتمام على المستوى الرئاسي بالمعارضين والقوى السياسية التي يمكنها تحدي خصوم الولايات المتحدة. ومن شأن هذا الجهد أن يبني على الإجراءات السابقة، كما حدث عندما التقى وزير خارجية ترامب، مايك بومبيو، وغيره من كبار المسؤولين مع نشطاء يسعون إلى الحرية في الصين، وعندما خاطب نائب مستشار الأمن القومي مات بوتينجر الشعب الصيني بلغة الماندرين من البيت الأبيض وعبر عن العديد من مخاوفهم بشأن الحكم القمعي للحزب الشيوعي الصيني.
قد يقول البعض إنه من النفاق أن تدين الولايات المتحدة بعض الحكومات القمعية، مثل تلك الموجودة في الصين وإيران، بينما تشارك مع حكومات أخرى، مثل الدول العربية غير الديمقراطية. ولكن من المهم النظر في قدرات البلدان على التغيير. معظم الملكيات العربية اليوم أكثر انفتاحا وليبرالية مما كانت عليه قبل عشر أو 20 عاما – ويرجع ذلك جزئيا إلى التعامل مع الولايات المتحدة. ولا يمكن قول الشيء نفسه عن الحكومتين الصينية أو الإيرانية، اللتين أصبحتا أكثر قمعا وعدوانية تجاه جيرانهما.
الولايات المتحدة ليست مثالية، وأمنها لا يتطلب من كل دولة على وجه الأرض أن تشبهها سياسيا. طوال معظم تاريخ الولايات المتحدة ، اعتقد معظم الأمريكيين أنه يكفي الوقوف كنموذج للآخرين بدلا من محاولة فرض نظام سياسي على الآخرين. ولكن لا ينبغي للأميركيين أن يستخفوا بما حققته بلادهم أو أن يقللوا من شأن نجاح التجربة الأميركية في انتشال الناس في الداخل والخارج من القمع والفقر وانعدام الأمن.
هل يمكن أن تحدث نهضة أميركية اليوم في دولة منقسمة، عندما تشير استطلاعات الرأي إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين يعتقدون أن بلادهم تسير على الطريق الخطأ؟ وكما أظهر انتخاب ريغان في عام 1980، يمكن للولايات المتحدة دائما تغيير الأمور. في تشرين الثاني/نوفمبر، ستتاح للشعب الأميركي الفرصة للعودة إلى منصبه رئيسا أعاد السلام من خلال القوة، ويمكنه أن يفعل ذلك مرة أخرى. إذا فعلوا ذلك ،فإن البلاد لديها الموارد والإبداع والشجاعة لإعادة بناء قوتها الوطنية ، وتأمين حريتها وتصبح مرة أخرى آخر أفضل أمل للبشرية