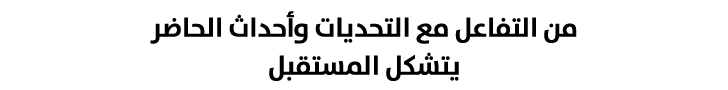صدمت اتفاقية بين السعودية وإيران بوساطة الصين واشنطن وأذهلتها، وهي التي أصبح من الصعب على السعوديين فهم تحولات سياستها الزئبقية.
بقلم لي سميث
مجلة تابلت
قال باراك أوباما لصحيفة The Atlantic في عام 2016: “إن المنافسة بين السعوديين والإيرانيين تتطلب منا أن نقول لأصدقائنا وكذلك للإيرانيين أنهم بحاجة إلى إيجاد طريقة فعالة لحسن الجوار وإقامة نوع من السلام البارد “.
من الصعب تحديد ما تعنيه سياسة الولايات المتحدة الحالية في الشرق الأوسط، والتي صممها أوباما لأصدقاء أمريكا، من جانب واحد، كما تعهدت الإدارة بقيادة نائبه السابق بايدن “بإعادة ضبط علاقتنا مع المملكة العربية السعودية” وهددت بـ “تهميش ولي العهد من أجل زيادة الضغط على العائلة المالكة لإيجاد بديل أكثر ثباتًا”. ووعد “بجعل [السعوديين] يدفعون الثمن، وجعلهم منبوذين كما هم”. من ناحية أخرى، حاولت إدارته إقناع محمد بن سلمان بضخ المزيد من النفط والمساعدة في إخفاء الآثار السيئة لسياسة الطاقة المحلية للبيت الأبيض، الآن يعلق مسؤولو إدارة بايدن والمؤثرون المرتبطون بها في مجتمع السياسة الخارجية بواشنطن، باتفاق سلام سعودي-إسرائيلي، يَعِدُ بمكافأة الرياض بالأسلحة التي رفضتها سابقًا عندما كانت المملكة تحاول فقط الدفاع عن نفسها من الميليشيات المدعومة من إيران والتي استهدفتها من حدودها الجنوبية.
ليس من المستغرب أن السعوديين أنفسهم لا يعرفون ماذا يفعلون بهذه الإشارات التي تبدو متضاربة، قال لي مستشار إعلامي سعودي، وهو ما سمعته مرارًا وتكرارًا خلال رحلة التغطية الإعلامية الأخيرة لشركة Tablet إلى الرياض وجدة، قال: “كنا شريك أمريكا في الحرب الباردة”. “العالم يبدو كما هو الآن لأننا عملنا معًا.”
تعود العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية إلى عام 1945 عندما أبرم فرانكلين روزفلت صفقة مع مؤسس الدولة السعودية الحديثة، الملك عبد العزيز “الحماية مقابل النفط الرخيص” ساعد التحالف الذي أبرمه الرجلان، في واحدة من آخر الأعمال المهمة التي قام بها روزفلت والتي شكلت نظام ما بعد الحرب قبل وفاته، في تشكيل إمبراطورية قوية، كانت الطاقة الرخيصة العمود الفقري للأمن الاقتصادي والوطني للولايات المتحدة، حيث غذت هذه الصفقة الدوريات المستمرة للبحرية الأمريكية في ممرات الشحن الدولية الحيوية، وضمنت قدرة البنتاغون على نشر قوات ضخمة في حالة التوغل السوفيتي على أراضي الحلفاء في أوروبا وخارجها.
في المقابل، صرف السعوديون شيك الضمانات الأمنية الأمريكية ضد كل خصم واجهته المملكة تقريبًا خلال الحرب الباردة: السوفييت، وإيران الثورية، وصدام حسين، ثم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، للمفارقة تمت تربية العديد من هؤلاء على الأراضي السعودية وتحريضهم من قبل الدعاة السعوديين الذين تسامحت معهم الحكومة نفسها، إن لم تكن تحت رعايتها – وهي العلاقة التي ساعدت في تعزيز هجمات 11 سبتمبر وأدت إلى مطالب الولايات المتحدة بإجراء إصلاحات شاملة في المملكة، استغرق الأمر عدة سنوات، لكن العديد من هذه الإصلاحات بدأت أخيرًا بشكل جدي في عهد الملك سلمان، لقد ذهبوا إلى قيادة هوجاء hyperdrive تحت ابنه محمد بن سلمان.
لقد أدهشتني أثناء رحلتنا إلى المملكة الأجواء المريحة في كل مكان ذهبنا إليه تقريبًا – تذكرنا لبنان سابقا- كما قال زميلي توني بدران (البلد الذي نشأ فيه). كانت المطاعم والمقاهي في المركز التجاري على شاطئ البحر في جدة مليئة بالعائلات والأزواج، وقد قيل لي في عشاء خاص عند أحد رجال الأعمال، منذ بضع سنوات فقط، عندما كانت السلطات الدينية لا تزال تراقب الأخلاق العامة، أن عازِفَي العود اللذين يغنيان في حفلنا الكبير هذا لم يكن ليكونا موجودين هنا قبل عهد محمد بن سلمان، وقال: “كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدخلت هنا وكسرت الأدوات وأمرت جميع الضيوف بمغادرة المنزل”.
يقوم مدعو آخر إلى هذا العشاء، الذي طلب مثل جميع محاوري السعوديين عدم الكشف عن هويته، بإرسال طفله إلى نفس الكلية على الساحل الغربي للولايات المتحدة التي التحق بها، إنه جزء من النخبة السعودية التي تثق في قدرة محمد بن سلمان على تنفيذ إصلاحاته بنجاح، والتي لا تستطيع أن تفهم سبب عدم رؤية صانعي السياسة الأمريكيين للسعودية الجديدة على أنها ناجحة، لقد طالبوا بالإصلاح ولديهم ذلك الآن، وأردف “إنه فوز لهم”. “ماذا يريدون منا؟”
هذا السؤال مهم لفهم السياسة الخارجية السعودية – وما قد تبدو عليه المنطقة في ظل رؤية أوباما لأمريكا ليس فيها حلفاء أو أعداء في المنطقة.
بدأت زيارتنا بعد فترة وجيزة من الإعلان عن اتفاقية تطبيع دبلوماسي بوساطة صينية بين المملكة العربية السعودية وإيران (العدو الإقليمي للرياض منذ بدء الثورة الإسلامية في عام 1978) كان تقرير صحفي قد وصف الاتفاقية بأنها “انتصار دبلوماسي آخر للصين في دولة خليجية عربية، ما يمثل انسحابا للولايات المتحدة ببطء من المنطقة “. أعرب خبراء السياسة الخارجية في بيلتواي – المؤيدون والناقدون للرئيس بايدن – عن دهشتهم، من أن الإدارة تركت العلاقات الأمريكية السعودية تنخفض إلى درجة أن الرياض اختارت بكين كوسيط مفضل لها.
ادعى السعوديون الذين تحدثت معهم في الرياض أن الهدف من الاتفاقية هو إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بعد أن سمح الإيرانيون للغوغاء المحليين بمهاجمة موقعين دبلوماسيين سعوديين في عام 2016. أخبرني أحد الصحفيين السعوديين البارزين في إدارة المطبوعات والإذاعة أن هدف الرياض من الصفقة كان مجرد شراء للوقت، وقال: “محمد بن سلمان يركز على أجندته الإصلاحية الداخلية”. “إذا كان الصينيون يستطيعون إبقاء الإيرانيين مقيدين حتى يعود الأمريكيون إلى رشدهم، فهذا في صالحه”.
السعوديون الآخرون الذين قابلتهم ليس لديهم ثقة كبيرة في أن بكين ستكون في وضع يمكنها من ضمان المصالح الأمنية السعودية بالفعل، أو حتى أنها قد ترغب في ذلك، وقال صحفي سعودي آخر “إنهم تجار وصناع صفقات”(في إشارة إلى الإيرانيين). “القيادة هنا تدرك جيدًا أنهم لن يسلموا أعناقهم لنا أو لأي شخص آخر.”
ومع ذلك، يبدو أن صفقة الصين أثارت قلق بعض مسؤولي بايدن، الذين كانوا قلقين من أن فك الارتباط السعودي عن الولايات المتحدة قد ذهب بعيدًا جدًا. في أبريل، زار مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز الرياض للتعبير عن مخاوفه من أن السعوديين كانوا يلعبون لعبة مزدوجة، بالإضافة إلى الاتفاق الذي توسطت فيه بكين، تحركت الرياض أيضًا نحو المصالحة مع دمشق بعد تجميد دام عقدًا من الزمن بدأ مع حملة بشار الأسد القاتلة ضد السكان السنة في سوريا، كان الوسيط المختار لهذه المحادثات هو موسكو، راعية الأسد منذ فترة طويلة، والتي زودته بالقوات والأسلحة خلال الحرب السورية.
عبر بيرنز عن إحباطه من السعوديين، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، وقال لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الولايات المتحدة شعرت بالصدمة من تقارب الرياض مع إيران وسوريا.
بدا كلام بيرنز الصارم كدليل على أن إدارة بايدن تعتقد حقًا أنها منخرطة في حقبة متجددة من “منافسة القوى العظمى” مع الصين وروسيا، ويبدو أن مخاطر هذا الصراع أكبر من أن حلفاء الولايات المتحدة يمكنهم أن يتلاعبوا بأعداء الأمريكيين، كما يقول بيرنز، لكن في اجتماع مع مسؤولين صينيين في فيينا في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بوساطة بكين بين الرياض وطهران، مشيرًا إلى أنه وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، “لم يكن بإمكان الولايات المتحدة أن تلعب دورًا مماثلاً بسبب كراهية متبادلة مع إيران “.
من الجدير بالذكر أن مسؤولي إدارة بايدن الذين ألقوا رسائل متناقضة بشأن دور الصين كوسيط بين السعودية وإيران – بيرنز وسوليفان – هما النائبان في إدارة أوباما اللذان التقيا سراً مع المسؤولين الإيرانيين في عام 2013 لإجراء مناقشات أولية حول ما سيصبح خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). كان الاتفاق النووي الإيراني هو حجر الزاوية في رؤية أوباما لشرق أوسط جديد، مع الرياض وطهران باعتبارهما ركيزتين متكافئتين للنظام الجديد الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
لكن كما أخبرني صحفيون سعوديون مقربون من الديوان الملكي، فإن الرياض لم تعتبر نفسها حتى قوة مهيمنة إقليمية، تقدم المملكة سلطة ثقافية ودينية بصفتها الوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة، على الرغم من ثروتها الهائلة، تظل المملكة العربية السعودية، في جوهرها، دولة تابعة، وفي معظم تاريخها الحديث، دولة تابعة لأمريكا، لذلك أظهر أوباما وبايدن إما ما أسماه المحلل الاستراتيجي الإسرائيلي دان شوفتان “مزيجًا مخيفًا من سوء قراءة سريالية للوقائع الإقليمية الأساسية وعدم الكفاءة الاستراتيجية الكاسحة” أو شيء أسوأ، أن الهدف الكامل من صفقة أوباما مع إيران، واستراتيجية إعادة التوازن التي استمرت في عهد بايدن، هي في الواقع تفكيك موقف أمريكا الإقليمي، وبالتالي تخليص نفسها من التزاماتها ومصالحها التقليدية في الشرق الأوسط ، كل ذلك بدافع الإيمان أن اللعبة لم تعد تستحق المجازفة بانجراف أمريكا إلى حرب في الشرق الأوسط في المستقبل.
إذا كان هذا هو الحال، كما يبدو أن العديد من السعوديين يعتقدون أنه ليس هناك حقًا حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا في نهاية المطاف، لو كان الأمر كذلك فلن تهجر أمريكا تحالفها الاستراتيجي الأكثر أهمية في المنطقة التي تنتج الجزء الأكبر من النفط في العالم.
من المرجح أن يوفر مستقبل النفط، كما يتخيله صناع السياسة في الولايات المتحدة والحزب الديمقراطي، الإجابة على هذا اللغز الواضح، فمع تصميم بايدن والديمقراطيين على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري – التشريع الذي يخصص تريليونات الدولارات للبنية التحتية للطاقة المتجددة – لم يعد يُنظر إلى السعوديين ومواردهم من الطاقة الطبيعية على أنهم يستحقون القتال من أجلها.
فبالنسبة للجانب الأمريكي، من الواضح أن الخطة هي استبدال المملكة العربية السعودية بالصين – الشركة المصنعة والموردة للجزء الأكبر من البنية التحتية للطاقة الخضراء في العالم، من الألواح الشمسية إلى توربينات الرياح إلى المعادن الأرضية النادرة للسيارات الكهربائية، المفارقة بالطبع هي أن الصين ستزيد فقط من وارداتها من الوقود الأحفوري من المملكة العربية السعودية، والتي تعد من الناحية التاريخية أكبر مورد للنفط لبكين، في غضون ذلك، ستستبدل الولايات المتحدة الاعتماد على المملكة العربية السعودية – دولة تابعة – بالاعتماد على الصين ، منافستها المزعومة، من الصعب تخيل كيف ستجعل أي من هذه التقلبات السياسية أمريكا أكثر أمانًا وازدهارًا، أو تقلل من حرق الوقود الكربوني.
بعد كل ما سبق، يبدو أن التغييرات في ثالوث الولايات المتحدة والسعودية والصين من المرجح أن تثري الصينيين وشركاءهم في الولايات المتحدة، لا سيما أولئك الذين يعملون في مجال الطاقة المتجددة وشركات التكنولوجيا ذات الصلة، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من القاعدة المالية للحزب الديمقراطي، في هذه الأثناء، ستكون الشركات الأمريكية التي تعتمد على الوقود الأحفوري، والتي تميل إلى التبرع للجمهوريين، بعيدة عن الحظ، ومن المفارقات أن الشراكة مع الصينيين قد تكون بالتالي أفضل طريقة للسعوديين لإطالة وتأمين علاقتهم مع الولايات المتحدة، فبالتوافق مع الصين، المملكة العربية السعودية لا تنفصل حقيقة عن أمريكا، بدلاً من ذلك، تستمر في اتباع خطى أمريكا – نحو مستقبل من المرجح أن يمارس فيه السعوديون نفوذاً أقل ولكن يتمتعون بقدر أكبر من حرية القرار في إطار علاقتهم مع حليف قوة عظمى زئبقي.