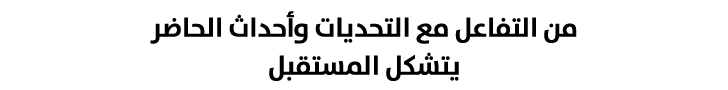الانتخابات الأمريكية: كيف يتفاعل الليبراليون مع هزيمة كامالا هاريس – إلقاء اللوم على الناخبين

جو غيل
ميدل إيست أي
٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤
سئم الناخبون الأمريكيون حروب بايدن التي لا نهاية لها ودعمه للإبادة الجماعية، لكن أنصارهم يرفضون التفكير في أسباب هذه الهزيمة
إذا فاز تأييد المشاهير بالانتخابات، فلن يخسر الديمقراطيون أبدًا. كان لدى كامالا هاريس تايلور سويفت وأوبرا وينفري وجورج كلوني وتشارلي إكس سي إكس وبيونسيه. ولكن من المؤسف أن الانتخابات يحددها الناخبون العاديون، بقدر ما يستطيع الناخبون أن يختاروا عندما يكون الاختيار بين نسختين سيئتين.
في أعقاب هزيمة هاريس المذهلة على يد دونالد ترامب، فإن صرير الأسنان وافتقار المعلقين الليبراليين إلى التأمل الذاتي هو أمر يستحق المشاهدة. لكي تكون ليبراليًا حقيقيًا، يجب عليك ألا تعرف شيئًا ولا تتعلم شيئًا، باستثناء كيفية إلقاء اللوم على الآخرين بسبب سياساتك المدمرة للذات.
لم يكن لدى الديمقراطيين ما يقدمونه لملايين الأمريكيين العاديين الذين يعيشون من رواتب إلى رواتب الذين تضرروا من التضخم في اقتصاد يخدم الأغنياء فقط. ومن الواضح أن قول هذا يعني تبرير السلوك المروع للناخبين الأمريكيين البيض. لكنني أكره أن أقسم الأمر إلى فقاعة إنستغرام الليبرالية: كانت قاعدة كامالا هاريس هي طبقة المانحين الرأسمالية، وليس الطبقة العاملة.
بالنسبة للعديد من الليبراليين، من الصعب جدًا محاولة فهم كيف تبدو الحياة من وجهة نظر الأمريكيين العاديين، سواء كانوا من البيض أو السود أو العرب أو اللاتينيين. لا، دعونا نستمر في إلقاء اللوم على الناخبين، فهو أكثر تطهيرًا – لقد فعلوا ذلك مرة أخرى، أيها الحمقى!
يعتقد مارتن كيتل من صحيفة الغارديان – وهو عضو منذ فترة طويلة في المعلقين الليبراليين – أن فوز ترامب سيمثل نهاية الولايات المتحدة باعتبارها “الأمة الأساسية والموثوقة في العالم الحر”. وهذه ليست الطريقة التي يُنظر بها إلى أميركا في عالم ينظر إليها في الأغلب الأعم باعتبارها دولة مارقة متعطشة للدماء.
يقوم كيتل بعد ذلك بجولة سريعة في عالم النبلاء العالميين في أمريكا مؤخرًا.
كان كل من باراك أوباما وجو بايدن مترددين في استخدام عصا أمريكا الغليظة، وكان آخرها وبشكل مأساوي في الشرق الأوسط. ولكن الآن، ليس هناك من يخفي عن الحقائق، كما يكتب، وهو يوجه نوعا من المخدرات المعتوهة المناهضة للواقع لوصف السياسة الخارجية للولايات المتحدة وكأن الحروب الأميركية الأخيرة لم تحدث قط.
حروب أوباما وبايدن
في الواقع، شهدنا خلال رئاسة أوباما «تصاعدًا» في أفغانستان، وقصف ليبيا وقتل معمر القذافي («لقد جئنا، ورأينا، ومات»، على حد تعبير هيلاري كلينتون)، وبرنامج الطائرات بدون طيار في باكستان، اليمن والصومال، بينما تدعم أيضًا الحرب السعودية في اليمن.
وفي سورية، انحرف أوباما عن التدخل المباشر في الحرب الأهلية بعد كارثة ليبيا. وبدلاً من ذلك، أشركت الولايات المتحدة الأنظمة العربية الموالية للغرب وتركيا لتولي مهمة مضايقة الدكتاتور السوري بشار الأسد بالقوات المسلحة. وكانت النتيجة النهائية هي الحرب الأكثر دموية في هذا القرن، على الأقل حتى وقت قريب.
وبعد ذلك، ولزيادة هذا التجاهل المزعوم، كانت هناك الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي تم تخميره في السجون التي تديرها الولايات المتحدة في العراق ما بعد الغزو، وهي الحرب التي كثفها ترامب.
وكما قالت منظمة أوقفوا الحرب في تعليقها بعد الانتخابات، فإن ترامب ليس صانع سلام عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والشرق الأوسط: “إن دعم ترامب لسياسة نتنياهو واضح. وعلى الرغم من كل حديثه عن رغبته في وقف الحروب، فإن سجله عندما تولى منصبه آخر مرة يُظهر أنه بعيدًا عن تحقيق السلام، فقد ضاعف جهوده في حرب الولايات المتحدة والحروب بالوكالة في سورية والصومال وأفغانستان واليمن.
في أعقاب فترة ترامب، انسحب نائب الرئيس أوباما المؤيد للحرب دائمًا، جو بايدن، بمجرد انتخابه، من أفغانستان (متبعًا سياسة ترامب)، مما وضع حدًا لحرب استمرت ٢٠ عامًا، وفي الوقت نفسه فرض عقوبات صارمة على السكان الذين يعانون من الفقر بالفعل.
أفضل، لمن؟
ومن دون توقف، غاص بايدن مباشرة في عملية فخ جيدة التخطيط في أوكرانيا، مع الوعد الكاذب بالتحرر من روسيا أمام الأوكرانيين – وهي الحرب التي كلفت حتى الآن ١٧٤ مليار دولار. لقد دفع الثمن الحقيقي مئات الآلاف من الأوكرانيين الذين يقاتلون الروس الأفضل تسليحاً. لقد وعد ترامب بإنهاء الحرب، التي سئم الناخبون الأمريكيون تمويلها (لا تستطيع حكومتهم حتى توفير المال اللازم لإجازة الأبوة المدفوعة الأجر لمواطنيها).
جاءت حرب بايدن الثانية في ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣: تم تسليم إمدادات غير محدودة من القنابل التي يبلغ وزنها ٢٠٠٠ رطل إلى بنيامين نتنياهو لتسوية غزة بالأرض في أعقاب هجمات حماس – وهي ليست “عصا غليظة” بقدر الحرب المروعة التي شنت ضد معسكر اعتقال مكتظ بالسكان، ثم توسعت إلى لبنان في ٢٠٢٤.
انتهى كل هذا، وليس من المستغرب، بهزيمة هاريس. ولا يستطيع كيتل أن يكبح مرارته تجاه الناخبين الأميركيين ــ وهو موقف ليبرالي للغاية في التعامل مع فشل الديمقراطيين الصادم. “لقد فعل الناخبون الأمريكيون شيئًا فظيعًا ولا يغتفر هذا الأسبوع. ولا ينبغي لنا أن نتوانى عن القول إنهم ابتعدوا عن الروح المشتركة والقواعد التي شكلت العالم، نحو الأفضل بشكل عام، منذ عام ١٩٤٥.
عموما للأفضل، لمن؟ هذا ليس سؤالًا يطرحه أي إمبريالي ليبرالي يحترم نفسه، لأن الإجابة واضحة جدًا بحيث لا يمكن ذكرها في صحبة مهذبة: الأمريكيون البيض والأوروبيون بالطبع. هل يمكننا حقاً أن نزعم أن العالم الذي تعيشه الغالبية العظمى من سكان الكوكب قد تحسن بشكل كبير تحت قيادة الولايات المتحدة، وخاصة في العقود الأخيرة؟
أطلقت الفوضى التي أطلقتها الحروب على المخدرات والحروب على الإرهاب منذ التسعينيات فصاعدا في أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط العنان لأزمة الهجرة التي يقول ترامب الآن إنه سيحلها عن طريق ترحيل ملايين المهاجرين.
الاستثنائية الأنجلوسكسونية
ولكي نكون منصفين لكيتل، فهو على حق في أمر واحد: أن انتخاب ترامب، والسياسات الأميركية التي يعود تاريخها إلى ما قبله، لابد أن تكون بمثابة نهاية للأسطورة الخطيرة التي تزعم أن بريطانيا والولايات المتحدة دولتان بارتان. “مع إعادة انتخاب ترامب، أصبحت الادعاءات بالقواسم المشتركة بمثابة خداع ذاتي خطير. نحن بحاجة إلى أن نفقد تلك النجوم المفتونة من أعيننا.
ما لم يقله هو أن ما وحد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة منذ هجمات ١١ أيلول كان المغامرات الإمبريالية، والرغبة في تحطيم الدول القومية وخوض حروب إلى الأبد باسم مكافحة الإرهاب، بينما يمنح الإرهابيين في الواقع السبب ذاته الذي يحتاجون إليه للقتال. وتحت هذا تكمن الاستثنائية الأنجلوسكسونية، المبنية على تاريخنا المشترك من الاستعمار الاستيطاني والنزعة العسكرية. وفي لبنان وغزة، أصبحت نتائج هذه السياسة واضحة للعيان: حرب مدمرة، وإبادة جماعية، بلا نهاية.
يعيد كيتل اكتشاف العقلانية في تحليله التاريخي الختامي: «جميع القوى الإمبريالية المتضائلة تتصارع مع ميراثها، كما تفعل قوى القرن التاسع عشر مثل بريطانيا وفرنسا وحتى روسيا بطرق مختلفة. والولايات المتحدة، التي أصبحت قوة استعمارية لاحقة بكثير، بالكاد بدأت هذه العملية.
ويتعين علينا إذن ألا ننجر إلى الهاوية بفِعل إمبراطورية الولايات المتحدة المتداعية، التي سمحت لبريطانيا بمواصلة خيالها المتمثل في كونها لاعباً عسكرياً رئيسياً على المسرح العالمي.
لكن في شخص كير ستارمر، ليس لدينا قائد يسمح لنا بالانفصال عن هذا “الماضي المتعجرف”. لقد ربط عربته إلى الولايات المتحدة، ومثل سلفه توني بلير، الذي دخل بغداد على ذيل جورج دبليو بوش، ليس هناك ما يشير إلى أن ستارمر لديه الشجاعة للتخلي عن حروب أمريكا المروعة في غزة ولبنان والشرق الأوسط الأوسع. .
هذه هي الحروب التي تخوضها أميركا دفاعاً عن الهيمنة والثروة الغربية، وهي حروب مبنية على إرث تقسيم الإمبراطورية البريطانية للمنطقة.
إذا كانت المملكة المتحدة محظوظة، فسوف يفعل ترامب ما وعد به وينهي كل هذه الحروب. وإلا فإن المملكة المتحدة سوف تنجر نحو المزيد من الفوضى الدموية والخزي، الذي سيدفع ثمنه بدماء عدد لا يحصى من العرب وربما الإيرانيين.